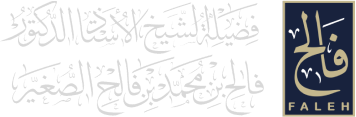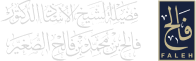الخطبة الأولى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، المبعوث رحمة للعالمين، بشّر وأنذر، وبلغ البلاغ المبين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، عباد الله! اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحشر: 18].
عباد الله! إن من محاسن الإسلام ومزاياه العظام، قيامه بكل إصلاح، إنه ليس عقائد وأخلاقًا فقط! وإنما هو مع ذلك موجه وحاكم وصاحب دولة وجهاد، وتنمية وإعداد، فالدين الإسلامي بعقائده وأخلاقه وآدابه وتوجيهاته وحكمه وحمايته للحقوق الخاصة والعامة، من أكبر الأدلة على أنه تنزيل من حكيم حميد، إذ شرع لهم هذا الدين، الذي لم يُبْق خيرًا إلا دل عليه، ولا شرًّا إلا حذر منه، ولا حقًّا إلا أقامه، ولا عدلًا إلا جعل له مسالك وطرقًا يقوم عليها، فهو دين ودولة، وجامع بين مصالح الدين والدنيا، وبين التسامح والتيسير، وبين العزة والقوة، والمقاومة لكل معاند محادّ للدين وأهله.
عباد الله! وإن الدين الإسلامي لم يدع شاذة ولا فاذّة من أمر الدين والدنيا إلا وضع لنا فيها منهجًا، يقول أبو ذر رضي اللَّهُ عَنْهُ : «لقد قام رسول الله ﷺ وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمًا»، وبالتالي فهو دين عطاء وتنمية في جميع المجالات، وهو دين حركة ونماء، وليس كلامًا في القراطيس والكتب! هو (إيمان في القلوب) تتحرك به حركة ملموسة في عالم الواقع، وتتخذ موقفًا محددًا من كل شيء حولها، وتصوغ سلوكها العملي على مقتضاه، فهو دين فطرة أعطى الإنسان حقه.
أيها المسلمون!
إن الحضارة الإسلامية تمارس كل ألوان النشاط البشري التي تؤدي إلى عمارة الأرض من علم وتجارة وصناعة، وتسعى إلى الإنتاج والتنمية في كل أبواب الإنتاج، ولكنها في سعيها كله تلتزم بالحلال، وبالقيم الأخلاقية وبما يقتضيه الإيمان بالله واليوم الآخر من تشكيل للسلوك ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: 77] فكان المسلمون في أجيالهم الأولى أمة نشطة في كل اتجاه، فكانت تجارة العالم في أيديهم من الصين إلى أوروبا! وكانت الصناعة المتاحة للناس في ذلك الوقت مزدهرة فـي مركز العالم الإسلامي المختلفة! وكان دور العلم عامرة بالأساتذة والطلاب في كل فرع من فروع المعرفة، من علوم الشريعة، إلى الفلك، إلى الكيمياء، إلى الرياضيات! وكانت هذه كلها مظاهر حضارية تقوم بها الأمة المسلمة.
عباد الله! ولكن هذا كله يمكن أن تقوم به أي أمة ممكنة في الأرض بوسيلة من وسائل التمكين، ولكن الذي تفردت به الحضارة الإسلامية- مع قيامها بالجانب الذي يمكن أن تقوم به كل أمة ممكنة في الأرض، أنها تقوم به بمقتضى «المنهج الرباني»، ولذا فإن من أعظم عوامل بناء المجتمع ونمائه هو تمسكه بالكتاب والسنة في جميع أحواله، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: 96] ويقول ﷺ : «تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدًا: كتاب الله وسنتي» رواه الحاكم، فالمعيار، ولا شك، هو الكتاب والسنة، مرجع المسلمين في كل أمر من أمور حياتهم، والمعيار كذلك هو حياة الأجيال الأولى من المسلمين التي طبقت هذا الدين في عالم الواقع، التزامًا بمقتضيات الإيمان، سواء كان في مجال التصور أو مجال السلوك، فكلما اقتربنا من الكتاب والسنة ومن حياة السلف الصالح رضوان الله عليهم، فنحن متقدمون عقديًا وسلوكيًا كذلك، وكلما تأخرنا عن الكتاب والسنة، فنحن متخلفون في مجال العقيدة، وبالتالي في مجال السلوك، وتلك أُولى الحقائق التي ينبغي ألا تغيب عن أذهاننا عندما نريد السعادة والبناء في المجتمع، ونريد طريق الخلاص، والتي ينبغي كذلك أن نستصحبها معنا دائمًا لكي لا نضل الطريق!
أيها المسلمون! إنه لا سبيل إلى إصلاح شيء من أمور الخلق الصلاح التامَّ إلا بالإسلام، وإن جميع النظم المخالفة لدين الإسلام لا يستقيم بها دين ولا دنيا إلا إذا استنبط من تعاليم الدين، وإن كان عاقل منصف يدرك صحة ذلك، فإن الدين كله صلاح وإصلاح، وكله دفع للشرور والأضرار، وكله يدعو إلى الخير والاستكثار، ويحذر من الشر وسوء الدار.
عباد الله! إن من أعظم الروافد التي جاء الإسلام بها، والتي أمر بها لتحقيق السعادة والإصلاح في بناء المجتمع المسلم هو التعاون بين أفراده، والاجتماع وعدم الفرقة، فإن من أعظم الأسباب وألزم الوسائل لسعادة الأمة هو وحدتهـا التي تجعلها كالجسم الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: 10] وقال ﷺ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» رواه البخاري.
فالاجتماع على الحق من أهم أسباب السعادة، وأقوى دواعي المحبة، فكم به عمِّرت بلاد، وسارت عباد، وانتشر عمران، وتقدمت أوطان، وأسست ممالك، وسهلت مسالك، إلى غير ذلك من فوائد الاتحاد الذي هو أعظم وأمتن الأسباب والوسائل، فهنيئًا لأمة اتحدت، وعلى الخيرات اجتمعت، فتفوز هذه الأمة فوزًا عظيمًا، وتبلغ شأوًا جليلًا، وتخلد لها ذكرًا جميلًا، على صفحات التاريخ بكرة وأصيلًا، وقد آخى الرسول ﷺ بين أصحابه، كان أحدهم يرث الآخر دون قراباته، وبذلك كانت نصرتهم على عدوهم، مع قلة عددهم، ففتحوا البلاد وهدوا العباد، قال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: 103] وأما التنازع والتفرق في الكلمة والرأي، فهو سبب الضعف والخذلان والفشل في جميع الأزمان، بل هو مجلبة الفساد ومطية الكساد ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: 46] فالويل والثبور لأمة دبت بينهم عقارب الخلاف وسرت فيهم ريح الشقاق، حتى قضي عليهم بالتشتت والفراق.
أيها المسلمون!
وإن من الأسس الراسخة في بناء المجتمع وتنميته: إيثار روح العلم والعمل والبُعد عن البطالة والكسل، فلا ريب أن حياة الأمة برجالها العاملين المخلصين لدينهم ومجتمعهم، فالعمل والجد راية الأمان لسعادة المجتمع والأوطان، وسبب لتقدم البلاد ونفع العباد، وقد قيل: «حرفة المرء كنزه»، وقال عمر بن الخطاب رضي اللَّهُ عَنْهُ : «إني لأرى الرجل يعجبني فأقول: هل له حرفة؟ فإذا قالوا: لا، سقط من عيني!».
عباد الله! وإن المتصفح لصفحات التاريخ يجد أن العمل الجاد من أهم دواعي سيادة الأمة الإسلامية على الأمم وترقيها في معارج المجد، ولقد أشار كتاب الله إلى أن سرّ النجاح في هذه الحياة وفي هذه المسيرة الإنسانية العظمى أنه يكمن في مواصلة العمل لا في الجمود والكسل، وفي التزام الصبر، لا في الجزع والملل، وفي التوكل على الله بعد اتخاذ الأسباب، وطرق أبواب رزقه التي ليس عليها حجاب، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۞ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [العنكبوت: 58، 59، 60].
أيها المسلمون!
لقد حث الإسلام على التقدم العلمي والعملي في جميع المجالات النافعة للإسلام والمسلمين، ولذا فإن الواجب على المسلمين النهوض بأمتهم عن مستنقع التخلف الذي تعيش فيه، وذلك بالاتجاه إلى الصحوة العلمية والعملية من التقدم الصناعي والحضاري، فهي متصلة بالتشريع الإسلامي، ولذا كان لزامًا على المسلمين أن يصرفوا جهودهم لتعلم الصناعات والعلوم التقنية بوضعها حاجة ملحة لا فكاك منها، فكما أن الرسالة الإسلامي تعنى بالشؤون الروحية، فإنها تعنى بشؤونه المادية المباشرة، بل تأخذه بيده فتسدد خطواته الأولى في نفس المجال التقني والصناعي، والآخرة التي دعا الرسل والأنبياء إلى الإيمان بها، إنما هي المرحلة الأخيرة في مسيرة جهاد الإنسان المتواصل، من أجل صلاح الإنسان وازدهار العمران، حيث يجني الإنسان ثمرة عمله، وليصل إلى تحقيق رجائه وأمله إن وفى بما عاهد عليه الله في خلافته، ولم يتنكر لدينه وشريعته ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الكهف: 7].
أيها المسلمون!
وأما ما يُظن من التلازم بين التقدم العلمي والمادي، وبين الانسلاخ من الدين والأخلاق، فأكذوبة لم يكن لها وجود إلا في نفوس العبيد مَنْ استعبدهم الغزو الفكري، فأنساهم ربهم، وأنساهم أنفسهم!! فإن الأمة كما هي بحاجة إلى العالِم الراسخ، فهي بحاجة كذلك إلى الطبيب الماهر، والمهندس البارع، والاقتصادي المبدع، وذلك نظرًا لتخلف الأمة الشديد في تلك الميادين كلها بعد أن كانوا أصحاب قدم ثابتة فيها وقت أن كانوا على جادة الإسلام! قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: 60] ولا ريب- عباد الله – أن مدى التقدم الصناعي خاصة، هو المعيار الدقيق لقدرة الشعوب على استثمار مواردها، وتدريب أبنائها، وسنظل نُستغل أسوأ استغلال ما لم نتمكن من إحداث نقلة صناعية نوعية، نوفر من خلالها فرص العلم لطلابه ومبتغيه، ونطعم الأفواه الجائعة ثم نوجههم إلى العلم بنفوس طائعة، ونفرض من التقدم العلمي احترامنا على الصعيد الدولي، ونداوي قبل ذلك بها جرحًا غائرًا في كبرياء مسلم اليوم!!
أيها المسلمون!
ومن أسس بناء المجتمع الثابتة ودعائمه الراسخة التي لا ينبغي إغفالها: التربية، فإن التربية هي طريق النجاح وسبب الخير والفلاح، بها يرتفع الإنسان من حضيض الهمجية إلى ذروة المدنية، وبها تستنير الأفهام، ويعلم الحلال والحرام، فكلما وُجد في الأمة دعاةٌ نصبوا أنفسهم لنشر الفضائل بين بنيها، وخصصوا ثمين أوقاتهم لغرس بذور التربية في نسيج أذهانهم، ركزت فيهم الملكات الفاضلة، وانطبعت فيهم الغرائز الكريمة، فيما أطيب ثمار التربية والتعليم! وما أحسن غرس بذور العلم في نفوس الناشئين والناشآت! أما إذا انفصمت عرى هذا المبدأ، وتداعمت قوائمه، وتناسى القائمون بالدعوة شأنها، وأهملوا أمرها، أسرع الفساد إلى أفراد الأمة، وتمكنت من نفوسهم الرذيلة ، وتغلبت عليهم الشهوات السافلة، فسعادة الأمم والمجتمع الإنساني إنما تكون بالتربية الفاضلة، وتهذيب النفوس ودعوتها إلى الخير.
وعوامل التربية كثيرة، ومنها الأم والأب والمعلم والمعلمة والمدرسة، ولذا تجد التربية تتفاوت، وبصلاح التربية تصلح الأمم، وبضياعها يفسد الكون، فويل لأمة لم تعتن بها، والله ما امتلأت السجون ويُتِّمت الأطفال واستحكمت حلقات الجهل إلا بترك التربية ، وإن الشخص الذي يُهمل سيكون أشد من الوحوش الضارية وأحط من البهائم، ومن تربى تربية صحيحة خليقٌ بأن يقود الأمة ويرفعها إلى معارج التقدم والنجاح، ويكون من الداعين إلى إعلاء كلمة الحق ورفع منار الإسلام.
عباد الله! إن الانحراف الضخم الذي وقعت فيه الأمة حتى أصبح الإسلام غريبًا، يحتاج إلى جهد ضخم وزمن غير قصير حتى نقود الأمة إلى الصراط السوي، أو حتى تعود فئة تحتمل الصراع والصدام مع أعدائها، وتصمد حتى يمدها الله بالنصر، ويمكن لها في الأرض، ويكون لها من رسوخ القدم في الإيمان وصدق العزيمة، والشجاعة في الحق والزهد في متاع الدنيا والحرص على ما عند الله في الآخرة ، ما يجعلها تحمل العبء صابرة محتسبة، ولن يتم ذلك إلا «بالتربية الجادة»، المحكمة التي تجعل الأمة تنهض من كبوتها وتقوم من غفلتها، حتى تعرف ما يُراد بها من مكر وكيد.
أيها المسلمون!
لابد إذًا من الجد والاجتهاد وتحمل أعباء الطريق الطويل، الطريق المجهد الشاق، البطيء الثمرة، الأكيد المفعول، طريق التربية؛ لإنشاء الجيل المسلم الواعي، ومن هنا نعلم خطأ الطرق التي يسلكها المتعجلون لجني الثمرة في طريقتهم في التربية، وأن كلها تؤدي إلى طريق مسدود، وإن بدا في ظاهر الأمر أنها هي الطريق التي تخرج بالأمة من حالة الجمود!
فاتقوا الله عباد الله وتحملوا مسؤولياتكم ليقوى الوعي لدى أبنائكم ومجتمعكم، فيفلح الجميع في الدنيا والآخرة. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه، وسنة رسوله ﷺ.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله رفع مكانة العلم والعلماء، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله من في الأرض ومن في السماء، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه النجباء، والتابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وساروا على المحجة البيضاء، أما بعد:
أمة الإسلام! ومن أهم أسس البناء وعوامل الخير والعطاء، التي تنهض بالأمة إلى معارج العز والبناء هي: شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن العالم الإسلامي جميعه جسم واحد، أعضاؤه الأمم، صحته الهدى، داؤه المنكر، دواؤه النصح والإرشاد، فإذا لم يأمر الآمرون بالمعروف، وينهى الناهون عن المنكر، لأصبحت الأمة طعمة للآكلين، وفريسة للقانصين، فأسرع إليها الفساد، وحقت عليها كلمة العذاب والشقاء ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌۭ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌۭ ﴾ [آل عمران: 104-105].
عباد الله! إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب صلاح المجتمع وحفظه وأمنه، فهو الدرع الواقي من الشرور والفتن، والسياج من المعاصي والمحن، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ [هود:117] فلم يقل: (صالحون) فقط، بل قالوا: ﴿مُصْلِحُونَ ﴾، والمصلحون هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال تعالى: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ۞ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة: 78-79] وقد تلا النبي ﷺ هذه الآية على أصحابه فقال: «كلا والله، لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد السفيه، ولتأطرنه على الحق أطرًا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم لَيَلْعننكُم كما لعنهم» رواه أبو داود.
فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لتفرق المجتمع واستشراء الفساد فيه، وتعطل مصالحه، وخلخلة الصف فيه.
فواجب على كل مسلم ومسلمة القيام بهذه الشعيرة على حسب الاستطاعة، وبخاصة فيما يقدرون عليه، من رفع منكرات البيوت وما في حكمها، وعلى كل صاحب علم وقلم وحكمة، أن يقوم بالإرشاد والتوجيه والنصح والسعي في ذلك.
أيها المسلمون!
ومع عظم هذه الشعيرة ومكانتها إلا أنه لا بد مع القيام بها التحلي بصفات تتحقق في فاعلها، فلا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والداعية عمومًا أن يتحلى بالعلم، بأن يكون عالمًا بما يدعو إليه وبما ينهى عنه، وإلا كان ضرره أكثر من نفعه، فإنه قد يأمر بما ليس بمشروع، وينهى عما كان مشروعًا، ومن الصفات كذلك أن يكون الداعية رفيقًا، وبأن يكون صبورًا على الأذى فيما يواجهه في سبيل الدعوة ونشرها.
عباد الله! إن المنهج الصحيح في الإصلاح والدعوة لا بد أن يكون منبثقًا من الكتاب والسنة، مراعىً فيه جانب الحكمة والموعظة الحسنة، لا أن يكون نابعًا من أهواء شخصية ورغبات ذاتية، أو يكون منطلقًا من صورة مشوشة ضبابية لم يتضح هدفها، ولم يُعرف غرضها، قال تعالى: ﴿قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: 108] وقال تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [النحل: 125].
أيها المسلمون!
لابد للدعوة عندما تؤتي أكلها أن تكون صادرة من رسوخ علمي ومعرفة بحال المجتمع وواقعه، ومعرفة ما يترتب على تلك الدعوة من مصالح ومفاسد، فإن دعوة الإسلام- ولله الحمد- واضحة المعالم، مستقيمة الطريق، وقوافلها سائرة لا يضرها من خذلها أو انحرف عن طريقها الصحيح، وعلى دعاتها أن يتمسكوا بالثبات على منهج النبوة في الصدق والوضوح، لا على الغبش والجنوح، ﴿قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: 108].
عباد الله! قد يؤدي التعجل أحيانًا في الدعوة إلى عمليات لا طائل من ورائها إلا إعطاء أعداء الله وأعداء الإسلام حجة لتقتيل المسلمين وتعذيبهم، والناس غافلون عن حقيقة المعركة وعن كون هؤلاء الأعداء إنما يعملون ما يعملون عداءً للإسلام ذاته لا ردًا على عمل معين!
أيها المسلمون!
إن استعمال العنف تأباه الشريعة الحنيفية وتجافيه، ونحن نعلم أن استخدام القوة والسلاح أو التشهير داخل المجتمع الإسلامي يظل مثقلًا بالقيود والشروط التي قد لا تكون موجودة مع استخدامها في جهاد الأعداء، وذلك لتجنب تمزيق المجتمع الإسلامي وتدميره من الداخل! وإن من مساوئ العنف أن يخنق كل الأنشطة الدعوية الأخرى؛ إذ إن استخدام القوة بشكل واسع سوف يغرز روح التوجس والخوف، كما أن الفريق المعادي يجد من العار أن يتقبل أفكار الذين يقاتلون، ولذا فإن الإصلاح القائم في جوهره على التسوية والتراضي والتنازل المتبادل لا يمكن أبدًا أن يحدث من وراء استخدام القوة الغاشمة، وإن الخطط الإصلاحية المتصلبة تفضي دائمًا إلى كوارث وحوادث رهيبة، والذين يسعون إلى الصدام بلا حكمة دائمًا يخسرون، والعاقل من اعتبر بغيره، والشقي من وعظ بنفسه.
﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: 21].
وصلوا وسلموا على خير الداعين والأمر به محمد بن عبدالله كما أمركم الله جل وعلا في محكم كتابه الكريم حيث قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾.

الوقت والإجازة الصيفية
الخطبة الأولى الحمد لله الواحد القهار، يكور النهار على الليل، ويكور الليل على النهار، وسخر الشمس والقمر، كل يجري إلى...

ألا إن نصر الله قريب
الخطبة الأولى الحمدلله جعل قوة هذه الأمة في إيمانها، وعزها في إسلامها، والتمكين لها في حسن عبادتها، أحمده سبحانه وأشكره،...

الحجُّ: آدابٌ ودروسٌ وتربيةٌ
الخطبة الأولى الحمد لله خص بيته الحرام بمزيد من التكريم، والتفضيل، وافترض حجه على من استطاع إليه السبيل، فارتفع النداء...

صلاة التطوع
الخطبة الأولى الحمد لله الذي جعل الصلاة راحة لقلوب الأخيار، وطريقًا للسعادة في دار القرار، أحمده سبحانه وأشكره، جعل الجنة...
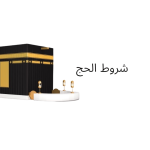
شروط الحج وأركانه
الخطبة الأولى الحمد لله على ما خصنا به من الفضل والإكرام، فما زال يوالي علينا مواسم الخير والإنعام، ما انتهى...