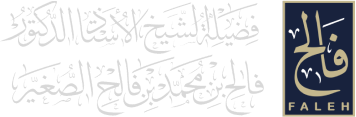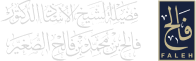الخطبة الأولى
الحمد لله رب العالمين، وعدهم بالنصر المبين، وتوعد الكفار بالعذاب المهين، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
عباد الله! اتقوا الله حق تقواه، وقوموا بحقه تكسبوا رضاه.
أيها المسلمون! يلاقي المسلمون في هذه الأعصار في عدد من الأمصار أعتى المآسي، وأدمى المجازر، فظائع دامية، وجرائم عاتية، ونوازل عاثرة، وجراحًا غائرة. غصص تثير كوامن الأشجان، وتبعث على الأسى والأحزان وما فلسطين إلا شاهد واضح للعيان.
أيها المسلمون!
لا يمكن أن تنتصر الأمة في ميادين الوغى إلا حين تنتصر على أنفسها وأهوائها، وتطبق شريعة الله في جميع مناحي حياتها، ويستقيم أفرادها على دين خالقها عندها تنتصر على عدوها، وتعلو كلمتها، وتحرس نعمتها، ويدوم عزها، وتشتد قدرتها، وتزداد قوتها، وتنفض الوهن عن عاتقها، ذلك الوهن الذي أخبر عنه رسول الله ﷺ بقوله: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا: يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينتزع المهابة من قلوب عدوكم، ويجعل في قلوبكم الوهن، قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت» أخرجه أحمد وغيره.
أيها المسلمون! إن لم تقم الأمة بذلك، فهي على خطر أن ينالها وعيد الله في قوله جل في علاه: ﴿ هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم﴾ [محمد: 38].
أيها المسلمون! حال الأمة اليوم لا تخفى على أحد؛ مآسي بكل المقاييس، وآلام ومصائب بكل المعايير، يعجز اللسان عن تصوير واقعها، ويخفق الجنان عند ذكرها، ويعيي البيان عن الإحاطة بها، فعلى المسلمين- وهم تنزل بهم النوازل، وتقع بهم الوقائع- أن يعلموا أن من دروس الابتلاءات الحاجة إلى المراجعة والمحاسبة، والضرورة إلى التمحيص والإصلاح وتقويم المسار.
إن الأمة يجب أن تعالج خللها من واقع دينها، وأن تصحح مسارها الخاطئ من منطلق أصول عقيدتها وتاريخها وحضارتها، وإن أولى الأولويات التي حان لكل الأمة أن لا تغفل عنها، هو أن المسلمين بحاجة ماسة للرجوع إلى الله، جل وعلا، واللجوء إليه، فذلكم هو النور العام من التخبط، والدرع الواقي من الاضطراب.
إن على الأمة أن تستيقن أنه لا سند إلا سند الله، ولا حول ولا قوة إلا بـه، ولا ملجأ منه إلا إليه، في محيط تثبيت لا يتزعزع لعقيدة التوكل على الله، وأن الأمة مكفية سوء البلاء ما استقامت على أمر الله، محفوظة من كيد الأعداء ما اعتصمت بحدود الله، أمة فقدت الثقة بربها، واضطربت أحوالها، وكثرت همومها، وضاقت عليها المسالك، وعجزت عن تحمل الشدائد، فلا تنظر حينئذ إلا إلى مستقبل أسود، ولا تترقب إلا الأمل المؤلم، اسمعوا إلى وصية النبي ﷺ: «يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت، فاسأل الله، وإذا استعنت، فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
لا عز لهذه الأمة، ولا منعة، ولا سلطان، ولا قوة إلا بدين الله، والالتزام بنهج كتاب الله، يقول عبدالله بن رواحة: وقد حانت غزوة مؤتة وعدد المسلمين ثلاثة آلاف، وجيش الروم مائتا ألف مقاتل، يقول عن الحقيقة الغائبة عن كثير من المسلمين اليوم: والله ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين: إما ظهور وإما شهادة.
أيها المسلمون!
فإذا أراد المسلمون العزة والتمكين في الأرض، فسبيل ذلك: أن ينصروا الله أولًا في أنفسهم، وأن ينصروا الله في أسرهم وبيوتهم، أن ينصروا الله في مجتمعهم وفي معاملاتهم، فيحكموا شرعه، ويطبقوا شريعته ﴿ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: 41] أربع عناصر واضحة للعز والتمكين: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
فالصلاة: هي علاقة بين العبد وربه عبادة جسدية، والزكاة: عبادة مالية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعله للإصلاح والتقويم من الخلل، ويعبر تعالى عن هذه المقومات للتمكين في آية أخرى بقوله: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 55].
فالأساس للتمكين والعزة والأمن والاستخلاف، عبودية لله تعالى، عبودية حقة، ونفي الشرك، عبودية شاملة ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 162].
وبدون هذه العبودية أو بالإخلال بها يهتز التمكين وتخدش العزة، وتحصل الذلة والهوان.
أيها المسلمون!
إن الأعداء في مختلف أنحاء الأرض لم ينتصروا بقواهم الخاصة بقدر ما انتصروا بضعف كثير من القلوب في إيمانها وإخلالها في عبودية ربها، وافتقار الصفوف إلى الوحدة والتراصّ.
فليست أثقال العسكرية، ولا القنابل الذرية، ولا الأسلحة الجرثومية، أخطر أسلحة عدونا، ولكن أخطرها وأمضاها زيوف الأفكار التي تسوق المسلمين إلى الدمار، وإطلاق الأهواء والغرائز والشهوات والأنانيات، وفشو الظلم، بعد اهتزاز ثوابت الإيمان، وضوابط الأخلاق، وبث روح اليأس والتيئيس في النفوس.
أيها المسلمون! إن المتأمل في هزائم الأمة، وصراعها مع أعدائها يدرك أن الجهود الماكرة للأعداء في ميادين التربية والتعليم والأعداء، هي أشد من أسحلتها المدمرة.
ومنذ عشرات السنين وخطط الأعداء في صد الأجيال عن القرآن الكريم، صدًا، وتجهيلهم بدينهم تجهيلًا. قوى كافرة ماكرة، إذا احتاج الأمر إلى اللين لانت، وإذا احتاج إلى القسوة بطشت، في لينها تدسّ السموم، وفي شدتها تقتحم الهمجية والجبروت، يخفرون كل ذمة، ويخادعون في كل قضية، الغاية عندهم تبرر الوسيلة، يجيدون العبث والتحريف والتجسس والإفساد.
أيها المسلمون! في هذه الأجواء كان ينبغي أن تكون الجباه ساجدة، والنفوس جادة غير هازلة.
أيها المسلمون! مع كل هذا، فإن العدو الخطير أهون مما يتصور المتشائمون والمذعورون، واليائسون والانهزاميون، إن الانتصار على الأعداء، ولو طال الزمن لا يتطلب إلا سلاحًا واحدًا، يستخدم سلاح الإيمان بالله، بصدق وإخلاص وجد في السلم وفي الحرب، وإخلاص التوحيد والعبادة، والعمل بالإسلام، فعلى المسلمين أن يعوا أن الإسلام وحده هو مصدر الطاقة، بإذن الله، الذي تضيء به مصابيحهم، وتنير به مشاعلهم، وبدون الإسلام ليسوا إلا زجاجات وقوارير فارغة لا يوقدها زيت، ولا يشعلها ثقاب.
ليس للمسلمين عز ولا شرف، ولا حق ولا كرامة إلا بالإسلام، إنهم إن أنكروا ذلك، أو تنكروا له فلن يجدوا من دون الله وليًا ولا نصيرًا، إنهم بغير الإسلام أقوام متناحرة، وقطعان مشتتة، بل سَقَطُ متاع، وأصفار من غير أرقام.
يجب أن تربى الأمة على الإقبال على الله لتسلم لها الحياة في دعائم موطدة من الدين القويم، والخلق المستقيم، في دعاء صادق تنطلق به الحناجر: ﴿وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: 147].
نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي سيد المرسلين، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلاَّ على الظالمين وأحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
أيها المسلمون! لقد مرت الأمة في تاريخها الطويل بأزمات كثيرة بل بنكبات عديدة، كان المسلمون يفقدون فيها تمكنهم في الأرض أحيانًا، وأحايين كثيرة كانوا يفقدون أمنهم وطمأنينتهم! وأحيانًا كانوا يفقدون ديارهم وأموالهم!
وهكذا الفتن والمصائب والنكبات- عباد الله- إذا نزلت بالأمم، وحلّت بالشعوب، لكن الأمة الإسلامية- مع ما سبق ذكره- مرت بتجارب قاسية، ومحن عاتية، ولكنها تجاوزتها، بإذن الله، بعد رجوعها إلى الله، وقد مرت بنا نماذج وأمثلة من نكبات وأزمات مرت بأمة الإسلام على مر تاريخها، ثم اجتازتها، وخرجت منها، لنصل إلى أزمتنا الحالية.
ارتدت قبائل العرب بعد وفاة النبي ﷺ عن الإسلام في زمن خلافة الصديق، أزمة حادة، ولا شك، دولة الإسلام كانت دولة ناشئة، دولة طرية، وكان أمامها عقبات كثيرة يطلب منها أن تجتازها! فتأتي قبائل بأكملها- كانت قد دخلت في الإسلام، وكان يؤمل عليها أشياء وأشياء- فإذا بالخبر أنها قد ارتدت عن الدين، ورجعت كافرة مشركة بعد أن كانوا مسلمين.
أزمة عظيمة، لكن منذ بدايتها، وفي أول لحظة منها لم يخالج الصحابة رضوان الله عليهم أدنى شك في أن النصر سيكون للدولة المسلمة، وليس للمرتدين هنا أو هناك!
لماذا انتصر المسلمون؟
لا شكَّ أن سبب هذا النصر أن صلتهم بربهم وإخلاصهم لدينه وصدقهم مع الله وإيمانهم الواثق به سبحانه.
وما كان من جزع الصحابة (رضوان الله عليهم) ومشورتهم على أبي بكر (رضي الله عنه) بالتريث في قتالهم، لم يكن ذلك لشك في نفوسهم أن الله سينصر دينه، إنما كانت مشورتهم من أجل إتاحة الفرصة لتجميع الجيش الكافي للمعركة.
ولكن إيمان أبي بكر (رضي الله عنه) الراسخ، وحساسيته المرهفة أبى أن يترك الخارجين عن أمر الله دون أن يسارع في توقيع العقوبة التي أمر الله بإنزالها بهم، كل ذلك قد فعل فعله في نفوس الصحابة (رضوان الله عليهم)، فوقفوا صفًا واحدًا خلف أبي بكر (رضي الله عنه)، ونصر الله دينه كما وعد، ومرت الأزمة بشكل طبيعي.
وما مر على أمة الإسلام: أزمة الحروب الصليبية وحروب التتار التي عصفت بالأمة وقتًا من الزمن، كانت أزمة حادة في حياة المسلمين، وبدا أنها يمكن أن تطيح بالأمة المسلمة كلها، وأن تجتث المسلمين من الأرض. لكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة الواقعية غير ذلك، وجاء النصر من عند الله في النهاية.
قال الله تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ﴾ [الرعد: 11] ﴿ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: 8].
فآن للأمة أن تعي الدرس الحقيقي ليراجع كل فرد نفسه، وينتصر على أهوائه وشهواته، هذه بداية التمكين والعزة.
وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه، فقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].

من نواقض الإيمان: النفاق
الخطبة الأولى الحمد لله شرح صدور عباده المؤمنين لطاعته، وأعانهم على ذكره، وشكره، وحسن عبادته، وحذر من الالتواء، والنفاق في...

مبطلات الصلاة ومكروهاتها
الخطبة الأولى الحمد لله الذي فرض الصلاة على العباد رحمة بهم وإحسانًا، وجعلها صلة بينهم وبينه ليزدادوا بذلك إيمانًا، وكررها...

خطبة عيد الفطر المبارك
الخطبة الأولى الله أكبر: (تسع مرات). الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد،...

توحيد الله في أفعاله (الربوبية)
الخطبة الأولى الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وهادي العباد، المنزه عن الشركاء والأمثال والأنداد، أحمده سبحانه وأشكره شكرًا لا...

أحكام الخطيب والخطبة
لقد أفردت هذا الفصل بالأحكام المتعلقة بالخطيب والخطبة لأهمية هذه الأحكام ولأن من المقاصد العظمى من يوم الجمعة هي هذه...