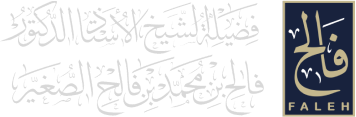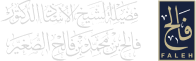الخطبة الأولى
الحمد لله قابل التوب، وغافر الذنب، يقبل العثرات ويستر العيوب، وبذكره تطمئن القلوب، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك المهيمن علام الغيوب.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم العرض والحساب.
عباد الله!
اتقوا الله حق التقوى، فمن يتق الله يجعل له مخرجًا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويجعل له من أمره يسرًا.
أيها المسلمون!
لقد تفشت في مجتمعاتنا ظاهرة ما كان لها أن تتفشى لولا ما عمت به البلوى من التفريط والغفلة، وكثرة المعاصي والذنوب.
إنها ظاهرة «القلق والهم والحزن» مرض العصر الذي أصبح انتشاره لا يفرّق بين كبير وصغير، أو غني وفقير، أو ذكر أو أنثى. بل تفشى بين فئات كثيرة بما يوجب وقفة للتأمل في أسباب هذا الداء؛ حتى يوصف لها الدواء الناجع بإذن الله تعالى.
عباد الله!
إن القلق هو داء نفسي يغشى النفوس، فيورثها حيرة واضطرابًا في شؤونها، وميلًا إلى العزلة، واسترسالًا مع الشكوك والظنون والأوهام. فإذا تمادى بالمرء دون وقفة علاج ربما أفضى به إلى أبعد من ذلك من آثار وخيمة عليه في شؤونه كافة، في أداء عمله، وحقوق أهله وبيته، وعلاقته بإخوانه وصحبه، فتتعطل طاقاته ومواهبه عن أداء دورها.
والأسوأ والأشد أن يفضي الاسترسال معه هذا الداء إلى التفريط في العبادات الواجبة، والوقوع في المحرمات المنهي عنها.
أيها المسلمون! إن هذا الداء بهذه الأوصاف داء غريب على مجتمعات المسلمين الذين حباهم الله بالنور المبين، نور الوحي المطهر، فلا يستحكم القلق في حياة امرئ مسلم إلا لغفلة شديدة عن كتاب الله وسنة نبيه ﷺ.
نعم، قد يمر بالإنسان من الأوقات ما يعتريه فيه بعض الأحزان والهموم إذا وجدت أسبابها؛ لأن الحياة الدنيا لا تخلو من الأكدار:
جُبلت على كدر وأنت تريدُهــا صفوًا من الأقذاء والأكـدار
وأوضح من هذا وأبين قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ [البلد: 4].
لكن شعار المسلم مع تقلبات الأمور وتغيرات الأحوال هو أن أمره كله خير، وعاقبته إلى خير، تصديقًا لقول النبي ﷺ: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرًا له» [رواه مسلم عن صهيب (رضي الله عنه).
كما أن المسلم يعلم أنه في هذه الحياة الدنيا كالغريب، أو عابر السبيل، فلا يشتد حزنه لشيء فاته منها، كما لا يشتد فرحه لخير حصل له فيها، بل منهاجه التوازن في كل ذلك، عملًا بما جاء في القرآن والسنة من الإرشاد إلى هذه الحقائق.
ومن ذلك قوله تعالى في قصة قارون: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص: 77].
وقول رسول الله ﷺ: «كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل» [رواه البخاري عن ابن عمر (رضي الله عنه)].
وقال ابن عمر (رضي الله عنه): «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أمسيت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك».
إن هذا الفهم الإيماني لحقيقة الحياة الدنيا يربأ بأهل الإيمان عن هذه الظاهرة، ففيم الجزع والقلق وهذه حقيقة الدنيا؟!
لكن الغفلة عن ذلك هي التي توقع في القلق النفسي، والناس يتفاوتون في ذلك، فمقل ومستكثر.
أيها المسلمون!
وغالبًا ما يكون القلق أحد أمرين:
تحسر على ماض، أو قلق على مستقبل.
فأما التحسر على الماضي لخطأ حصل، أو فوات مصلحة، أو غفلة عن فرصة، ونحو ذلك؛ فسببه ضعف الإيمان والتسليم بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، والمسلم القوي الذي يستعين بالله ولا يعجز أحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
ولو استحضر الباكي على فوات أمر مضى أن تباكيه لن يرجع ذلك الأمر لهدأت نفسه، فما البال وهو مع ذلك يخسر ثواب الصبر على ما أصابه، ما لم يقع فيما هو أشد من ذلك، وهو التسخط، عياذًا بالله من سخطه وغضبه؟ فمن رضي بالمقدور، فله الرضا من ربه، ومن سخط فله السخط.
وأما الخوف من المستقبل والقلق بشأنه، فآفة تؤرق الخاطر، وتجلب الغم فـي الحاضر، على شيء في علم الغيب، لن تؤثر فيه هذه المشاعر!
وقد يكون من أجل رزق، أو وظيفة، أو منصب، أو جاه، أو قبول جامعة، وغيرها مما يشغل بال الكثيرين، ثم لا يكون في الواقع إلا ما يريده الله تعالى ويقضيه.
ولو أن المرء توكل على الله حق توكله، وجعل همه الآخرة؛ لأتته الدنيا وهي راغمة، كما روى الترمذي، عن أنس رضي الله، عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له».
فاتقوا الله، عباد الله، وتوكلوا على ربكم ومولاكم، فإن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم، وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم.
وليستفد المرء من ماضيه، ويعمل لحاضره، ويخطط لمستقبله، دون أسف على ماض فائت، ودون حرقة على مستقبل لا يدري ما الله صانع فيه، وليعلم أنه مهما عمل، فلن يرجع أمرًا ماضيًا، ولن يعلم عن المستقبل. ولكن عليه العمل في حاضره وما أعطاه الله، ويتفاءل بما سيجري عليه، ويحسن الظن بالله تعالى، ومن أحسن الظن بالله كان الله معه.
أيها المسلمون!
وقد يكون من أسباب حدوث القلق وجود بعض المشكلات الاجتماعية في البيت أو العائلة أو في العمل والوظيفة، وهذه بلا شك تجعل الإنسان غيـر مستقر، لكن إذا أُخذت بمنظار هادئ غير مستعجل، ودرست تلك المشكلات ووضعت في مقامها الصحيح، فإنه لا مشكلة إلا ولها حل وبهذا لن توصله للقلق والمرض، بإذن الله.
أسأل الله تعالى أن يمن علينا بالطمأنينة والسكينة. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها المسلمون! هذا هو الداء المَرَضي.. قلق يغشى النفس ويكدر صفوها، مظاهره حزن على فائت فات ومضى، أو خوف على مستقبل في علم الغيب لا يعلمه إلا الله.
لكنَّ هناك بونًا شاسعًا بين الهم الجالب للاغتمام، وبين الهمة العالية التي تدفع المرء للتفكير في الاستفادة من ماضيه، والتخطيط لمستقبله، أو حزن لارتكاب منكر، أو مشكلة وضائقة حلّت به. فإذا كان هذا هو ما يحس به المرء، فهو على خير بإذن الله.
وكذلك ما هو عرضي يمر على سائر البشر، ومنهم الأنبياء والمرسلون، كالحزن على مصيبة دون استمرار هذا الحزن وملازمته للإنسان، حتى يصير ظاهرًا عليه.
أما القلق المؤذي للنفس، والمسبب للاضطراب وعدم الاستقرار والطمأنينة، والمقعد عن العمل والعبادة والقيام بالحقوق والواجبات؛ فهو الداء العضال الذي يجب أن يبادر بالعلاج قبل أن يستحكم ويفضي إلى ما لا تحمد عقباه.
وهو ما يعيشه كثير من الناس اليوم، حتى استولى على حياتهم، وأقعدهم عن كثير من مناشطهم، وأصبح وسيلة لأمراض أخرى كالاكتئاب والشك والوسواس وانفصام الشخصية، والحنق على النفس والمجتمع، واستيلاء الغيرة والغضب على نفسه وأسرته والناس، فصار همّه التردد على المستشفيات النفسية والرُقاة، وأخطر من ذلك التردد على الكهّان والمشعوذين.
أيها المسلمون! إن هذا القلق هو الذي يجب المبادرة إلى الوقاية منه، وإلى علاجه عند وقوعه.
ومن أهم وسائل الوقاية والعلاج: تنمية شعيرة التوكل على الله والثقة به، والرضا بقضائه فيما قدر وقضى، والمؤمن مع ذلك يدافع البلاء بالدعاء، فلا يـرد القضاء إلا الدعاء، كما في الحديث عن النبي ﷺ.
ومن أسباب العلاج العظيمة كذلك: اللجوء إلى الله بالعبادة في أوقات القلق والكرب، كما جاء في الحديث عن النبي ﷺ، أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فليلجأ المسلم إلى ربه معتصمًا به، عابدًا وداعيًا؛ فيطمئن قلبه ويهدأ روعه ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28].
ومن أهم الوسائل: كثرة الاستغفار والتوبة، فكثير من أسباب البلاء ما جاءت إلا بذنب، ولا ترفع إلا بالتوبة، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: 33].
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): «ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة».
ومن الوسائل المهمة يا عباد الله: نبذ العداوة والشحناء، وتنظيف القلب من الحسد والبغضاء، وعدم التطلع ومد العين لما لدى الآخرين، قال الله جل وعلا: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ [طه: 131].
وقال النبي ﷺ: «انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم» [رواه مسلم عن أبي هريرة (رضي الله عنه)].
فهذه النصوص الكريمة تشير على أن القناعة وسلامة الصدر من أعظم ما يسعد به الإنسان ويطيب نفسًا، وينشرح صدرًا في هذه الحياة الدنيا، فكل متاعها إلى زوال ﴿ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: 64] أي الحياة الكاملة الحقيقية.
فعلام يجزع الإنسان لما لم يُقسم له من متاع فان؟! ولماذا يحسد غيره حتى يأكله الحسد والحقد، ولا يعلم هذا أن هذا الحسد اعتراض على الله تعالى في قدره وقضائه؟!
ألا قل لمن كان لي حاسدًا أتدري على من أسأت الأدب
أسأت على الله في حكمـه لأنك لم ترض لي ما وهـب
فعلى المسلم أن ينظف قلبه من هذه الأمراض القلبية التي تورثه أمراضًا أخرى.
ومن العلاج أيضًا: كثرة ذكر الله تعالى؛ فبالذكر تسكن القلوب وتنشرح الصدور: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28] سواء كان هذا الذكر قرآنًا يتلى، أو ثناء على الله، أو دعاء وتوسلًا به جل وعلا.
أيها المسلمون!
الوسائل لعلاج القلق كثيرة، بل إنها أسباب الوقاية منه في الأساس لمن هداه الله وشرح صدره، يجمعها قوة الإيمان واليقين بالله جل وعلا ومعرفة حقيقة هذه الحياة الدنيا، وأنها مزرعة للآخرة.
ثم يُقال لمن أصيب بشيء من ذلك واستمر معه مع عمله بما ذكر من العلاج: لا مانع من التطبب بالرقية الشرعية عند الموثوق بعلمهم وديانتهم، أو عند الأطباء الموثوقين بعلمهم الطبي وديانتهم.
والحذرَ الحذرَ من اتباع المشعوذين والسحرة والدّجالين، فإنهم لا يزيدون المريض إلا مرضًا، والواهن إلا وهنًا، والمصاب إلا مصيبة، وبُعدًا عن ربه.
أسأل الله تعالى أن يحفظنا بالإسلام والإيمان والقرآن، وأن يحفظنا من وساوس الشيطان، ومن شر شياطين الإنس والجان، ثم صلوا وسلموا على رسول الله كما أمركم الله جل وعلا في محكم التنزيل حيث قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب: 56].

الحج: حكم وأسرار
الخطبة الأولى الحمد لله الذي أمر خليله ببناء البيت الحرام، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه وخيراته الجسام، وأشهد أن لا...

رمضان مدرسة الصالحين
الخطبة الأولى الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب، وفتح لهم من خزائن رحمته وجوده كل باب، أحمده سبحانه...

بصائر لذوي الضمائر
الخطبة الأولى الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا هو مالك الملك، عالم الغيب والشهادة، يحكم بين عباده فيما كانوا...

استشعار عظمة الله
الخطبة الأولى الحمد لله وحده لا شيء قبله، ولا شيء بعده، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، قدر الليل والنهار، وقدر...

وقفاتٌ مع أحداث فلسطين
الخطبة الأولى الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، أحمده سبحانه حمداً...