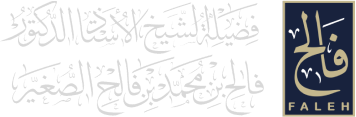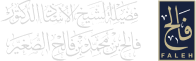الخطبة الأولى
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستهديه، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وصفوته من خلقه، قائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
عباد الله! اتقوا الله وتأملوا في كتابه، ففيه العظة والعبرة، والشفاء والرحمة.
أيها المسلمون! كتاب الله تعالى حافل بالحكم والأمثال والقصص، وهي معالم إيمانية هادفة، يقف عندها المؤمنون ليقتبسوا منها الدروس والعبر، ويربطوا ذلك بواقعهم تطبيقًا عمليًّا، فلم يكن ذكر هذه القصص والأمثال من أجل ترفيه فكري أو معرفة تاريخية أو معلومة ثقافية، بل هي في الحقيقة تجسيد أوامر الله تعالى ونواهيه على شكل قصة عابرة لأفراد أو أمم بأعيانهم، كما جاء ذكر المؤمنين من أصحاب الكهف: ﴿نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ [الكهف: 13] أو هي أمثال وحكم كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 74]، أو هي وصايا للحكماء والصالحين لأهلهم وذويهم كما في وصية لقمان لابنه وهو يعظه في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَـٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَـٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌۭ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍۢ وَفِصَـٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ۞ وَإِن جَـٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌۭ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًۭا ۖ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ۚ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ يَـٰبُنَىَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍۢ مِّنْ خَرْدَلٍۢ فَتَكُن فِى صَخْرَةٍ أَوْ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ أَوْ فِى ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌۭ ۞ يَـٰبُنَىَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ۞ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍۢ فَخُورٍۢ ۞ وَٱقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَٰتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴾ [لقمان: 13-19].
وسنقف في هذه الخطبة على هذا النوع الأخير وهو وصية لقمان لابنه، ولنقف مع تلك النصائح والوصايا التي يلقنها لابنه، وهي مجموعة من المعالم التي ترسم صورة الإسلام الحقيقية، حيث جاءت تلك الوصايا بأسلوب تربوي لطيف، تفوح منه العاطفة الأبوية الجياشة والشعور الصادق مع ابنه، ومعلوم أن علاقة الوالد مع ولده مبرأة من أية شبهة أو مصلحة، إن مثل هذا النصح والتعاطف الرائع مع الولد، يحتاج إليه الآباء مع أبنائهم وبناتهم وأزواجهم، ويحتاج إليه المربون والمدرسون في ميادين التعليم والتربية، ويحتاج إليه العلماء والدعاة في مسيرتهم العلمية والدعوية، ويحتاج إليه المسؤولون مع من تحت أيديهم؛ لأن اللين والمرونة في التخاطب والتحدث يجعل المتلقي أكثر استعدادًا لقبول الكلام والموعظة، يقول الله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [النحل: 125].
ويقول عليه الصلاة والسلام: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه».
وبالمقابل، فإن الغلظة والشدة في التخاطب ينفّر المستمع، ويسدّ أذنيه عن سماع القول والإنصات إليه، قال الله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: 159].
أيها المسلمون! أولى الوصايا التي أوصى بها لقمان ابنه هي: قضية التوحيد، في قوله: ﴿يَـٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ وهو إقرار بتوحيد الله تعالى ونفي الشرك عنه بكل صوره وأشكاله، وإفراده تعالى بالعبودية المطلقة، وهذا التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق وبعث الرسل وأنزل الكتب، وهو الأمر الذي يتوقف عليه سائر الأعمال، فالأعمال انعكاس واقعي لعقيدة الإنسان، فإن فساد العقيدة يفسد الأعمال والأفعال، ولو كان ظاهريًا صحيحًا.
فيبين لقمان لابنه نقيض التوحيد وهو حقيقة الشرك وعاقبته: يا بني إن الشرك أكبر أنواع الظلم على الإطلاق، لأنه إجحاف بحق الله تعالى في إفراده بالعبودية، هذا الذي خلقه، وأغدق عليه نعمه ظاهرة وباطنة نعمًا لا تعد، ولا تحصى، ثم أرسل إليه رسلًا مبشرين ومنذرين، وفتح له أبواب رحمته في جميع الأوقات لقبول توبة المذنبين والمسرفين، وبعد ذلك كله يأتي الإنسان ويشرك بالله، إن هذا لهو الظلم الوخيم، والفعل الشنيع، وهو ما صرح به عليه الصلاة والسلام حينما سئل أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك» رواه البخاري ومسلم.
أيها المسلمون!
ثم يتابع لقمان الحكيم وصيته لابنه، وهي الوصية الثانية، فيدخل معه في ملكوت الله تعالى وكونه، وعلمه جل وعلا بأمور هذا الكون كلها، صغيرها وكبيرها، حتى لا يخفى عليه أمر تلك الذرة المتناهية في الصغر بلا وزن ولا قيمة، والتي تخفى عن البشر؛ لأنها تائهة وضائعة في هذا الملكوت الرباني الواسع في صخوره الصلبة أو سماواته الواسعة والممدودة، أو في أرضه.
إن أمر هذه الذرة لا يخفى على اللطيف الخبير الذي يعلم مستودعها ومستقرها: ﴿ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان: 16].
ثم ينتقل لقمان الحكيم إلى الوصية الثالثة التي تعد أهم أركان الإسلام العملية وهي الصلاة ﴿ يَـٰبُنَىَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ وإقامتها أداؤها على أكمل وجه، بالمحافظة والمداومة عليها في وقتها، وإقامتها في المساجد مع جماعة المسلمين، وعدم التخلف عن ذلك إلا من عذر؛ من مرض أو خوف أو غير ذلك، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة والتهاون فيها، قال عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث حسن صحيح.
ويقول عبدالله بن مسعود رضي اللَّهُ عَنْهُ : ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. رواه مسلم.
ثم تأتي وصية لقمان الرابعة لابنه، وهي تذكيره بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الإنسان لم يوضع على ظهر هذه البسيطة ليأكل ويشرب وينام، وإنما هو خليفة الله تعالى في أرضه، عليه حمل أداء رسالته ودينه إلى الناس، وإصلاحهم بالطرق المشروعة التي أشار إليها هذا الدين، وذلك ببيان سبل الخير والصلاح لهم ودعوتهم إليها، وبيان سبل الشر والفساد ونهيهم عنها، فإذا تركت الأمة هذا الأمر، فلتعلم أنها قريبة من غضب الله تعالى وعقوبته، حتى لا يستجاب دعاؤها، يقول عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم»
هذا وقد ربط الله تعالى خيرية هذه الأمة بأداء هذا الفرض وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بقوله تعالى: ﴿ نتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [آل عمران: 110].
ثم يوصي لقمان الحكيم ابنه في وصيته الخامسة بالصبر على ما يعتري دعوته ومسيرة حياته من صنوف الأذى والابتلاء، وهي المحك الذي يميز الخبيث من الطيب، والصالح من الفاسد، وهو ما أشار إليه ربنا جل شأنه بقوله: ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ [الملك: 2].
وكأن لسان حاله يقول لابنه وفلذة كبده: يا بني إن وجود الإنسان على هذه الأرض لم يكن سدى أو ضربًا من العبث، وإنما هو لغاية سامية تعلو كل الغايات والآمال، ومن أجل تحقيق ذلك لابد وأن يصيبك من أذى الناس ما يصيبك، فعليك يا بني أن تتزود وتتقوى بزاد الصبر في مواجهة الصعاب والتغلب عليها، في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، كما قال تعالى: ﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 177].
وكما قال عليه الصلاة والسلام: «يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر» رواه الترمذي.
ويقول أيضًا: «حُفَّتْ الجنة بالمكاره وحُفَّت النار بالشهوات» رواه مسلم.
أيها المسلمون! حري بكل مسلم وبالذات الشباب أن يستفيدوا من هذه النصائح العظيمة والوصايا الجليلة فهي منهاج حياة وسبيلٌ إلى النجاة في الدنيا والآخرة.
نفعني الله وإياكم بهدي كتابه، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
أيها المسلمون! ثم يحذر لقمان الحكيم ابنه في وصيته السادسة من مرض نفسي فتاك، وفعل مقبوح يبغضه الله تعالى، وتنفر منه النفس الإنسانية، والذي كان سببًا في إخراج إبليس من الجنة وطرده من رحمة الله تعالى، ألا وهو الكبر: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [لقمان: 18].
والصَّعَر مرض يصيب الإبل، فيلوي أعناقها، وجاء هذا التشبيه دلالة على قبح هذا الفعل وكراهته، وفي الحديث القدسي يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منها قذفته في النار» رواه أبو داود.
والكبر والتعالي على خلق الله تعالى وعلى نعمه وآلائه من أهم أسباب العذاب والهوان التي تنزل بالأمم كما أشار إلى ذلك ربنا ﻷ: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴾ [الأحقاف: 20].
والكبر ينفر الناس من صاحبه، ويجعله صغيرًا ذليلًا في عيونهم، وكما قيل: فإن مثل المتكبر كمثل رجل في أعلى جبل يرى الناس حوله صغارًا والناس يرونه كذلك صغيرًا.
ثم جاءت الوصية السابعة من لقمان الحكيم لابنه بالاعتدال في المشي والرفق في الخطى أثناء المشي، وعدم إضاعة طاقة المشي في الأمور التافهة التي تجلب الضرر وتؤذي العباد ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ [لقمان: 19] فلا بد وأن تكون خطوات الإنسان في المشي وسعيه في الأرض من التنقلات الكثيرة والأسفار المتتالية، يجب أن يكون ذلك ضمن مشروع إيماني ومصلحة دعوية.
ولكن حال الأمة تنطق بعكس ذلك، وواقعها المعاصر يشهد على أبنائها بخلاف ذلك، والشواهد ما نراه ونسمع من خروج كثير من الشباب إلى خارج البلاد في الإجازات والعطل تلبية لنداء الشيطان وإغوائه للناس للوقوع فيما حرمه الله تعالى من الفواحش والمنكرات، حيث يقطع هؤلاء الشباب آلاف الأميال، ويصرفون آلاف الريالات، ويعانون أتعاب السفر وأعباءه من أجل شهوة جامحة ونزوة هائجة، أما كان الأولى بهؤلاء أن يبذلوا تلك الجهود والإنفاقات في سبيل الله وعلى طاعة الله، أو الخروج في سبيل مصلحة مباحة، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
وتأتي الوصية الأخيرة من لقمان الحكيم لابنه، وهي التحلي بأدب الكلام والتخاطب مع الناس، قائلًا: ﴿ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ﴾.
لأن غض الصوت يدل على صدق صاحبه في كلامه وحديثه، وعلامة على رفعة أدبه وسمو أخلاقه، بخلاف ذلك الذي يزعق ويصرخ في أحاديثه مع الناس، وهو علامة اضطراب وعدم الصدق في الحديث، وجاء ربط رفع الصوت والزعق فيه يذكر بصوت الحمير لتدل على قبح هذا الفعل وشناعته المنفرة للنفوس والأطباع.
أيها المسلمون! إن الوصايا التي وصى بها لقمان الحكيم ابنه بها، لجديرة أن تأخذ مكانها في واقع الناس وحياتهم، الآباء والأمهات في البيوت، والمدرسون والمربون في المدارس والجامعات، والمديرون في الشركات والمؤسسات، والعلماء والدعاة في ميادين العلم والدعوة، كل واحد في مكانه الذي يعمل فيه ويتحرك في مجاله، ولكن بأسلوب حكيم وتخاطب مرن ولين، ليتحقق المأمول من هذه الوصايا والنصائح في واقع الناس وحياتهم.
وصلوا وسلموا على خير المتقين، وخليل رب العالمين، تفوزوا في الدنيا والدين، كما أمركم الله جل وعلا بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾.

الجود في رمضان
الخطبة الأولى الحمد لله أعاد وأبدى، وأنعم علينا من النعم والجود وأسدى، أحمده سبحانه وأشكره على آلائه ونعمه التي لا...

أسباب الهزيمة والنصر
الخطبة الأولى الحمد لله رب العالمين، وعدهم بالنصر المبين، وتوعد الكفار بالعذاب المهين، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله...

البيت المسلم
الخطبة الأولى الحمد لله معز من أطاعه، ومذل من عصاه، أسبغ علينا نعمه المتوالية وآلاءه المتتالية، أحمده سبحانه وأشكره، من...

التقوى
الخطبة الأولى الحمد لله رب العالمين، أمر بتقواه، ووعد المتقين خيرًا كثيرًا، أحمده سبحانه ولي المتقين، وأشهد أن لا إله...

التعليم مسؤولية الجميع
الخطبة الأولى الحمد لله علَّم بالقلم، علَّم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له،...