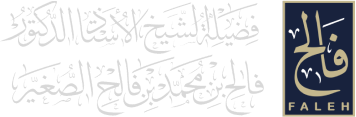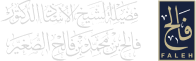الخطبة الأولى
الحمد لله رب العالمين، ولي المؤمنين، امتن علينا بسلوك سبيل الناجين، أحمده، سبحانه، وأشكره على نعمه حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة من النار يوم الدين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده، ورسوله، أفضل الأنبياء، والمرسلين، وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله، وأصحابه الغر الميامين، والتابعين، ومن تبعهم، وسار على نهجهم إلى أن يبعث الله الخلق أجمعين، أما بعد:
عباد الله: اتقوا الله، وآمنوا به يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورًا تمشون به، ويغفر لكم بعفوه، ومنته.
أيها المسلمون: عقيدة المسلم تقوم على الإيمان بأركان الإيمان الستة، قال تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: 285] ، وجاء في حديث جبريل المشهور، عندما سأل رسول الله، ﷺ، عن الإيمان، قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره».
أيها المسلمون:
والركن الثاني من أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة الكرام، وهذا الإيمان يعني: التصديق بوجودهم، وبأعمالهم التي كلفهم الله بها في هذا الكون، خلقهم الله تعالى، لينفذوا أوامره، ويعبدوه حق عبادته، ويقوموا بالمهام التي أسندها إليهم ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: 6].
والملائكة من عالم الغيب لا يراهم البشر، ولا يعرفون عددهم، ولا كيفيتهم، وخَلْقهم، ولكن يجب أن يؤمنوا بوجودهم إيمانًا جازمًا وأنهم خلقوا من نور.
أما صفاتهم التي أخبر الله عنها: فهم من أعظم جنود الله قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [الفتح: 7] وبيّن، سبحانه، شيئًا من مهامهم، وهيئاتهم بقوله سبحانه: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فاطر: 1] فمنهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، أو أربعة، أو أكثر، وقد رأى النبي، ﷺ، جبريل (رضي الله عنه) وله ستمائة جناح.
وأعطاهم الله سبحانه قوة عظيمة بحيث لو صاح المكلف منهم في الخلق لأهلكهم، كما حدث مع قوم ثمود، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ [القمر: 31] وذلك عندما صاح بهم جبريل (رضي الله عنه) فقطعت هذه الصيحة قلوبهم في أجوافهم، ومثل ذلك عندما رفع جبريل بجناحه قوم لوط، وهم في سبع قرى، حتى سمع الملائكة نباح كلابهم، وصياح ديوكهم، ثم قلبها عليهم، ومثله نفخ إسرافيل (رضي الله عنه) في الصور، كما قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ﴾ [الزمر: 68].
وأعمال الملائكة مختلفة، فمنهم من هو موكل بحمل العرش، وعددهم أربعة، ويزيدون يوم القيامة، فيصيرون ثمانية، ومنهم من يقوم على جهنم، وهم خزنة جهنم، أي: الموكلون بالنار، وتعذيب أهلها، ومنهم من هو موكل بالوحي، وبالأجنّة في بطون الأمهات، يأمرهم الله لتمام أربعة أشهر بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي، أو سعيد، وبالقطر من السماء، والنبات في الأرض، وبقبض الأرواح، وبحفظ أعمال بني آدم، وكل إنسان معه ملكان موكلان به، ومنهم من هو موكل بضرب وجوه، وأدبار الكافرين عند الموت، قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ [الأنفال:50] وملائكة لسؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، وملائكة يبشرون المؤمنين بالجنة ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: 30] وملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا الصحف، وجاؤوا يستمعون الذكر، وما بين موضع شبر إلا ملك في السماء قائم أو ساجد، فسبحانه من خالق عظيم! وبأعمال كثيرة لا يعلمها إلا الله.
وأسماؤهم منها المعروف المسمّى لنا، كجبريل، وميكائيل، وإسرافيل، ومالك خازن النار، ومنهم من لم يسمّ لنا، والجميع ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [غافر: 7].
أيها المسلمون!
يجب على المؤمن أن يؤمن بالملائكة على سبيل الإجمال، فيما أجمل، وعلى سبيل التفصيل، فيما فصل، وهذا من أركان الإيمان، لا يتم إيمان العبد إلا به.
أيها المسلمون!
والركن الثالث من أركان الإيمان: هو الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله تعالى على رسله، عليهم الصلاة والسلام، ويعني ذلك الإيمان بأنها أنزلت من عند الله حقًا لا مرية فيه، فيؤمن العبد بذلك إيمانًا إجماليًّا، ويؤمن بما سجل فيه تفصيلًا، كالتوراة التي أنزلت على موسى( عليه الصلاة والسلام) والإنجيل الذي أنزل على عيسى (عليه الصلاة والسلام) والزبور الذي أوتيه داود (عليه الصلاة والسلام) وآخرها، وخاتمها القرآن الكريم الذي أنزل على نبينا محمد، عليه الصلاة والسلام، ويلزم من هذا: الإيمان بها، والتصديق بما أخبرت به مما لم يحرف منها، والعمل بما نسخها كلها، وهو القرآن الكريم.
قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: 48] أي حاكمًا.
والإيمان بالكتب، ركن من أركان الإيمان لا يتم إيمان العبد إلا به، ومن يخالفه فقد عرض نفسه للكفر، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: 136].
أيها المسلمون: والكتب السماوية كلها من عند الله تعالى، أنزلت هداية للبشر، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ [النحل: 36] وقررت قواعد مشتركة، ومنها مسائل الإيمان، والدعوة إلى العقيدة الصافية، والسلوك الحسن، ومكارم الأخلاق، والحكم بالعدل بين الناس، ومحاربة الشر والفساد، والانحراف، وجاءت بكثير من العبادات، كالصوم، والحج، ولكنها تختلف اختلافًا كبيرًا في كثير من الشرائع التفصيلية، ومن الإيمان بالكتب، الإيمان بأن القرآن الكريم هو خاتمها، وأشملها، وأطولها، وأحسنها، والحاكم عليها، فهو الكتاب الذي ختم الله به جميع الكتب، وقد تكفل سبحانه بحفظه، ولا يقبل من أحد سواه، وهو المتعبد بتلاوته، والأمر بالعمل بأوامره، وهو كلام الله المنزل على رسوله، ﷺ، وهو الذي «لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه».
أيها المسلمون!
ومن مقتضى الإيمان بهذا الكتاب المبين قراءتُه، وترتيله، وتأمله، وتدبره، وحفظه، أو حفظ شيء منه، وتصديق أخباره، والإيمان بمحكمه، والوقوف عند متشابهه، والعمل بأوامره، والانتهاء عن زواجره، وعبادة الله وفق ما شرع فيه.
أيها المسلمون!
المسلم الحق، هو الذي يراجع آثار الإيمان بملائكة الله وكتبه، وبالقرآن خاصة، فلذلك الإيمان آثار على الفرد، والمجتمع، والأمة.
فمن آثار الإيمان بالملائكة: أن هذا الإيمان يقرّب إلى الله، تعالى، فإذا علم العبد أن عليه ملائكة يحصون أعماله، فذلك معين له على عمل الخير، واجتناب الشر، ولا يظن أنه لا يطلع عليه أحد: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الانفطار:10-12]، فهم يكتبون كل صغيرة، وكبيرة، ويحصونها على العباد.
ومن آثار الإيمان بالكتب: أنه يقوي إيمان العبد، ويقربه من ربه، ويسير بمقتضاه على صراط مستقيم، لا اضطراب، ولا اعوجاج فيه، وبه يؤدي شكر نعمة الله عليه، ويسلم من الزيغ والانحراف، والتخبط الفكري، والعملي، وبه ينشرح الصدر، ويطمئن القلب، ويفرح بنعمة الله، ومنته، مهتديًا بهديه، ويظهر أثر ذلك الإيمان في الآخرة بالنجاة يوم القيامة، ودخول الجنة، وفوق ذلك كله رضا الله، سبحانه وتعالى.
أيها المسلمون!
في تعامل كثير من الناس اليوم مع هذين الركنين العظيمين أخطاء فادحة، فالذين لا يؤمنون بالملائكة، ولا بأعمالهم، أو لا يؤمنون بالكتب المنزلة من عند الله، أو يفضلونها على القرآن الكريم، أو يقولون: هي سواء، ولا يعتبرون للقرآن منزلته التي جعلها الله له، أو لا يصدقون بهذا القرآن، أو يتهمون جبريل (رضي الله عنه) أو محمدًا ﷺ في نقصانه، وعدم بيانه، أو يرون تعاليم البشر، وقوانينهم مثل تعاليم القرآن، وتوجيهاته، أو يرون تعاليمه تعاليم بائدة، أو وقتية، أو صلحت لزمان الرسول ﷺ ولا تصلح لزماننا هذا، زمن الطائرة، والحاسب، وغيرها، أو هو مجرد تراث مقدس للافتخار، والتباهي، وليس للعمل به، ونحو هذه الآراء، فمن اعتقد شيئًا من ذلك، فقد ضل ضلالًا بعيدًا، وكفر كفرًا بواحًا.
أما أولئك الذين لا يقرؤونه، ولا يتلونه حق تلاوته، ولا يحفظون شيئًا منه، ويتساهلون في تطبيق بعض تعاليمه، ولا يعملون بتوجيهاته، فهؤلاء على خطر عظيم، ومزلق خطير، فليتنبه هؤلاء وأولئك ليعبدوا النظر في إيمانهم، وتجديده في نفوسهم، جعلني الله وإياكم من المؤمنين الصادقين، ونفعني وإياكم بما في القرآن العظيم من الآيات، والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون، أحمده سبحانه، وأشكره على نعمه، وآلائه، ولو جحدها الجاحدون، وأشهد أن لا إلا إله الله وحده لا شريك له شهادة حق، وصدق، ولو كفر بها الكافرون، وأشهد أن سيدنا، ونبينا محمدًا عبده ورسوله الرسول المجتبى، والنبي المصطفى، ولو كذّب به المكذبون، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، ولو سبهم المنحرفون، والتابعين، ومن تبعهم، واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد:
أيها المسلمون!
أما الركن الرابع من أركان الإيمان: الإيمان بأن الله تعالى أنعم على الناس بإرسال رسله إلى خلقه مبشرين، ومنذرين؛ ليدلوهم إلى الحق، ويرشدوهم إلى الهدى، وينيروا لهم الطريق، ويوجهوهم إلى دروب الخير، والرسول: هو كل من أوحى إليه من البشر بشرع، وأمر بتبليغه، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به، أرسلهم الله تعالى، ليأمروا الناس بعبادة الله وحده، ونبذ كل ما يعبد من دونه، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ [النحل: 36].
والرسل: بشر مخلوقون، أكرمهم الله تعالى بإرسالهم إلى عباده، فليس لهم من صفات الربوبية، والألوهية شيء، قال تعالى عن نبيه محمد، ﷺ: ﴿ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 188] ويعتريهم ما يعتري البشر من الحاجة إلى الطعام، والشراب، والمرض، والموت، وغيرها، قال تعالى عن إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) في وصفه لربه: ﴿وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۞ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ﴾ [الشعراء: 79-81].
وأولهم نوح (عليه الصلاة والسلام) وآخرهم، وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد، ﷺ، الذي نسخ الله تعالى بشريعته سائر الشرائع، وبدينه سائر الأديان.
والإيمان بالرسل يعني: الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله تعالى، فمن كفر برسالة واحدة، فقد كفر بالجميع، ويجب الإيمان بهم جميعًا إجمالًا، وبمن علمناه تفصيلًا، كأولي العزم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [غافر: 78].
ومن لوازم الإيمان بهم تصديق ما جاء من أخبارهم، وكذا العمل بشريعة من أرسل إلينا، وهو محمد ﷺ الذي هو خاتم الرسل، والمرسل إلى جميع الثقلين، الإنس والجن، والعمل بها يقتضي تنفيذ أوامره، واجتناب نواهيه، وألا يعبد الله إلا بما شرع، عليه الصلاة والسلام.
أيها المسلمون!
للإيمان بالرسل ثمرات جليلة من أعلاها: العلم برحمة الله لعباده، حيث امتن عليهم بإرسال هؤلاء الرسل، فيعبدون الله حق عبادته. ومنها: شكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، ومنها: تقدير رسل الله، عليهم الصلاة والسلام، وما قاموا به من مهمة البلاغ، وكذا: الاقتداء بهم، واتباعهم، والنهل من ميراثهم النبوي الكريم، ومنها: تحقيق عبودية الله تعالى، في الأرض، وكذا النجاة من النار، ودخول الجنة.
أيها المسلمون!
إن الذي يضع الرسل فوق منزلتهم، كمن يجعلهم بمنزلة الله، تعالى، فيجعل لهم حق العبودية، أو كمن يدعوهم بعد موتهم، أو يغالي فيهم، أو يطوف حول أضرحتهم، أو يتوسل إليهم بعد موتهم، فهؤلاء، وأمثالهم خرجوا عن الإيمان بالرسل، وغلوا غلوًا يخرجهم من الإيمان بالله.
أما من يعصي أوامرهم، أو يشكك في أخبارهم، أو لا ينزل على حكمهم، أو يفضل أحكام سائر البشر على أحكامهم، فهؤلاء على خطر عظيم بحسب ذنبهم الذي اقترفوه، وقد يخرجون به إلى الكفر، أو النفاق، أو إلى كبيرة من كبائر الذنوب.
أيها المسلمون:
لنصحح إيماننا برسل الله، ولنعظم حقهم، ونقدرهم حق قدرهم، فلا نغالي فيهم إلى حد الألوهية، ولا نجافي جفاء يجعلنا على خطر من عدم اتباعهم.
وصلوا، وسلموا، وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، ﷺ، المبعوث رحمة للعالمين، ومخرجهم من الظلمات إلى النور، كما أمركم الله تعالى في محكم كتابه العزيز حيث قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].

المعاقون والمعاقات
الخطبة الأولى الحمد لله، الذي خلقنا في أحسن تقويم، فسبحانه من عليم حكيم، أحمده سبحانه وأشكره على فضله العميم وأشهد...

وقفات مع نزول الأسهم وكثرة الغبار
الخطبة الأولى الحمد لله الواحد القهار، خلق السموات والأرض والجبال والبحار، وصرّفها بقدرته بما يشاء ويختار، من رزق وخير وأمطار،...

وقفات حول بعض الأحداث
الخطبة الأولى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وجعل الأرض قرارًا ومهادًا وبساطًا، وجعل منها رواسي أن تميد بكم، وجعل...

في وداع رمضان
الخطبة الأولى الحمد لله، وفق من شاء لطاعته، فكان سعيهم مشكورًا، ثم أجزل لهم العطاء والمثوبة، فكان جزاؤهم موفورًا، أحمده...

أركان الصلاة
الخطبة الأولى الحمد لله ذي الفضل والعطاء والإحسان، جعل إقامة الصلاة من أركان الإسلام، أحمده سبحانه وأشكره على ما امتن...