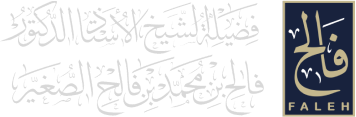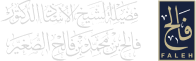لقد أفردت هذا الفصل بالأحكام المتعلقة بالخطيب والخطبة لأهمية هذه الأحكام ولأن من المقاصد العظمى من يوم الجمعة هي هذه الخطبة وما يتبع ذلك من صلاة الجمعة ولهذه سأذكر في هذا الفصل إن شاء الله مسائل متعلقة بالخطيب والخطبة.
وفي هذا الفصل مبحثان:
المبحث الأول: مسائل متعلقة بالخطيب
مهمة الخطيب شاقة ولا ريب، مشقة تحتم عليه أن يستعد الاستعداد الكافي في صواب الفكر، وحسن التعبير، وطلاقة اللسان ووجوب الإلقاء، ومطلوب من الخطيب أن يُحدث الناس بما يمس حياتهم ولا ينقطع عن ماضيهم، ويردهم إلى قواعد الدين ومبادئه يبصرهم بِحكمهِ وأحكامه برفق، ويُعرفهم آثار التقوى والصلاح في الآخرة والأولى.
1 ـــ المسألة الأولى: آداب الخطيب على قسمين:
القسم الأول: آداب عامة، ومنها:
- حسن المظهر:
على الخطيب أن يلبس أحسن ما يجد من الثياب، فروى البخاري بابا «يلبس أحسن ما يجد».
- الحكمة:
لا شك أن صاحب الحكمة يتذوق الناس لذة التأدب على يديه، ويستقبلون كلامه بارتياح ورضا، وحسن قبول، لأنه يستخدم الأسلوب الحكيم في التعامل معهم، ويضع الأمور في مواضعها الصحيحة امتثالًا لأمر الله سبحانه وتعالى ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [النحل: 125] .
- التبشير:
التبشير هو بث الأمل في القلوب والبعد عن أساليب التنفير، فيكون تشجيعًا لهم لأداء العبادات، وممارسة الحياة بتفاؤل ورجاء، وحسن ظن بالله تعالى.
- الصبر:
الصبر من أعظم صفات الخطيب، ونظرًا لأهميته فقد جعل الله- تبارك وتعالى- الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين.
فقال الله عَزَّ وَجَلَّ قائل: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: 24].
ومتى تصور الخطيب لإرشاد الناس وهدايتهم، فقد استشرف لغمز كثير من الناس ولمزهم.
- قوة الشخصية:
إن قوة الشخصية تجعل كلام الخطيب سلطانا ساحرًا في أعين الناس وقلوبهم، وهي هبة من الله يهبها من يشاء من عباده وبوسعنا أن نصل إليها، إذا صلحت منا السرائر.
- جودة النطق:
فيخرج الحروف من مخارجها من غير تشدق أو تكلف فيلقيها حسنة صحيحة واضحة.
القسم الثاني: آداب الخطيب الخاصة:
الآداب السابقة ذكرها هي متعلقة بالخطيب والمتكلم من جهة العموم سواء كان خطيب للجمعة أو غيرها أما الآداب الخاصة التي ستأتي في هذا القسم فهي خاصة بالخطيب يوم الجمعة.
- تحضير الخطبة:
لابد لك- أخي الخطيب- من تهيئة نفسك للتحضير بإفراغها من الشواغل، حتى تكون نيتك صافية، ورغبتك قوية، فإن الأمر الشاغل مانع لك من سداد الرأي وتسلسل الأفكار.
اختيار الموضوع المناسب زمانا ومكانا وتوافقه مع حاجة المخاطبين:
الحرص قدر الإمكان أن يلائم موضوع الخطبة الأحداث الجارية والملابسات الواقعة في دنيا الناس ومخاطبة جماهير السامعين فإنه مما يزري أن تكون الخطبة في واد والناس والزمان في واد آخر، وإن في نزول كتاب اللهم منجمًا مما ينبه إلى ذلك ويدل عليه.
- الحرص على الإيجاز قدر الإمكان:
فيحسن بالخطيب الاقتصار في الخطبة على موضوع واحد غير متشعب الأطراف ولا متعدد القضايا إذ أن ذلك في الغالب يشتت الأذهان وينسى بعضه بعضًا. ثم إن كثيرًا من المصلين قد أتى مبكرًا للصلاة فيؤذيه التطويل فيكون سببًا لتأخيرهم جمعًا قادمة.
- تحديد الناس بما يعلقون:
لكل مقام مقال ولكل جماعة لسان فالحديث إلى طلبة العلم غير الحديث إلى الأغنياء، والحديث إلى العامة غير الحديث إلى العِلية، وخطاب الأميين غير خطاب المثقفين. وهكذا.
- السلام على المأمومين إذا أقبل عليهم:
استحب جمهور أهل العلم كابن عباس وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، والشافعي وأحمد وغيرهم أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا صعد المنبر.
واستدلوا بما رواه البيهقي وابن ماجه عن جابر أن النبي ﷺ: «كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة: قال السلام عليكم».
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «وإن كان الحديث المرفوع فيه ضعف لكن الأمة عملت به، واشتهر بينها أن الخطيب إذا جاء وصعد المنبر فإنه يسلم على الناس، وهذا التسليم العام.
أما الخاص فإنه إذا دخل المسجد سلم على من يلاقيه أولًا وهذا من السنة بناء على النصوص العامة أن الإنسان إذا أتى قومًا فإنه يسلم عليهم. فيكون إذا للإمام سلامان:
السلام الأول: إذا دخل المسجد سلم على من يمر به.
السلام الثاني: إذا صعد المنبر فإنه يسلم تسليمًا عامًا على جميع المصلين.
- يسن أن يخطب قائمًا:
لحديث جابر بن سمرة رضي اللَّهُ عَنْهُ : «أن النبي ﷺ كان يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقول فيخطب قائمًا، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسًا ، فقد كذب» ولأن ذلك أبلغ بالنسبة للمتكلم، لأن القائم يكون عنده من الحماس أكثر من الجالس، ولأنه أبلغ أيضًا في إيصال الكلام إلى الحاضرين، لا سيما في الزمن السابق، إذ ليس فيه مكبر صوت.
- ليس أن يقصر الخطبة:
يقول النبي ﷺ : «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه».
فالأولى أن يقصر الخطبة، لأن في تقصير الخطبة فائدتين:
- أن لا يحصل الملل للمستمعين، لأن الخطبة إذا طالت لا سيما إن كان الخطيب يلقيها إلقاءً عابرًا لا يحرك القلوب، ولا يبعث الهمم فإن الناس يملون ويتعبون.
- أن ذلك أدعى للسامع أي: احفظ للسامع، لأنها إذا طالت أضاع آخرها أولها، وإذا قصرت أمكن وعيها وحفظها.
وعلى الإمام أن يراعي الحال فإن استدعاء التطويل أطال وإن رأى الاختصار اختصر ولا يخرجه تطويله عن كونه فقيها.
- أن يجلس بين الخطبتين:
لحديث عبدالله بن عمر رضي اللَّهُ عَنْهُ قال: «كان النبي ﷺ يخطب خطبتين يقعد بينهما».
جمهور أهل العلم على استحباب هذه الجلسة.
والحكمة من هذه الجلسة بين الخطبتين مما ذكره الحافظ ابن حجر : بقوله: «قيل:للفصل بين الخطبتين، وقيل: للراحة. وعلى الأول وهو الأظهر يكفي السكون بقدرها».
قال الحافظ ابن حجر: «وقدرها من قال بوجوبها بقدر جلسة الاستراحة، وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص».
أما يقال في الجلسة بين الخطبتين فينبه ابن قدامة رحمه الله : «ولنا أنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع».
وأورد الحافظ ابن حجر الحديث الذي رواه أبو داود بلفظ: «كان النبي ﷺ يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب».
قال الحافظ ابن حجر: «واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه، لكن ليس فيه نفي أن يذكر الله أو يدعوه سرًّا».
2 ـــ مسائل متفرقة:
أ- حكم تحين المسجد للخطيب:
نقل النووي في المجموع عن المتولي: أنه لا يصلى تحية المسجد، وأنها تسقط بسبب الاشتغال بالخطبة، كما تسقط في حق الحاج إذا دخل المسجد الحرام بسبب الطواف.
ب- إذا خطب رجل وصلى آخر:
والسنة أن يصلي بالناس صلاة الجمعة من تولى خطبتها لمداومة النبي ﷺ على ذلك، وقد حافظ عليه الخلفاء الراشدون من بعده ، وقال عليه الصلاة والسلام «صلوا كما رأيتموني أصلي» وقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» لكن إن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز وصحت الصلاة، وإن فعل ذلك بغير عذر كان خلاف السنة وصحت الصلاة على الصحيح من قولي العلماء.
ج- المسألة أخذ الأجرة على خطبة الجمعة:
أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية على ذلك بقولها: «يجوز للقائمين على شئون المسجد أخذ مرتب على ما يقومون به من شؤون المساجد، سواء في ذلك الأئمة والخطباء والمؤذنون والفراشون، لقيامهم بواجب إسلامي عام واشتغالهم بالمصالح العامة». وبالله التوفيق
د- الخطيب يخطب بورقة تأتيه من وزارة الشئون الدينية:
أجابت اللجنة الدائمة بما نصه: «تجوز صلاة الجمعة خلفه إذا كانت خطبة مشتملة على الثناء على الله والصلاة على النبي ﷺ والموعظة الحسنة والأمر بتقوى الله تعالى، ولا منافاة بين ذلك وبين كونها في ورقة تأتيه من وزارة الشئون الدينية».
هـ- طهارة الخطيب:
ذكر الفقهاء عدم اشتراط الطهارة للخطبة، فلو خطب وهو محدث فالخطبة صحيحة لأنها ذكر وليست صلاة.
و- تشبيك الخطيب بين أصابعه:
قد يحتاج الخطيب في خطبته إلى تحريك يديه للتمثيل، فقد يشبك بين أصابعه اقتداء بالنبي ﷺ كما في الصحيحين من حديث أبي موسى عن النبي ﷺ قال «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا» وشبَّك ﷺ بين أصابعه.
أما الآداب عن أحاديث النفي فيقال لا تعارض، إذ المنهي عنه هو فعله على وجه العبث، والذي في الحديث إنما هو المقصود التمثيل وتصوير المعنى في النفس بصورة الحس.
المبحث الثاني: أحكام الخطبة
- مقدمة بين يدي الموضوع أهمية الخطبة:
لا يخفى أفضلية يوم الجمعة، واختصاص هذه الأمة به، وانتظار الناس – في هذا اليوم- للخطيب والمتطلع للخطة، ومع ذلك تبدو أهمية الخطبة لعدة أمور منها:
- إلزام الناس شرعًا بالسكوت والاستماع للخطيب، و«من مس الحصى فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له».
- يجتمع للخطباء عدد متنوع الناس، فيهم الغني والفقير والمتعلم والجاهل والرئيس والمرؤوس والصغير والكبير بل والذكر والأنثى.. ومخاطبة هؤلاء كلهم فرصة لا يتوفر سماعهم وإنصاتهم في غيرها.
- خطبة الجمعة أسبوعية، ولذا ينبغي أن يتوفر لها من الصدق والتأثير ما يجعله الناس زادًا لهم حتى مجيء الخطبة التي تليها.
- أنها المنبر الواجب بخلاف المنابر الأخرى التي غايتها الاستحباب وبعضها محل خلاف ومن هنا وجب الاهتمام بها.
- منازعة المنابر الأخرى ووسائل الاتصال مما يجعل لها أهمية خاصة ، وإن زهد بها كثير من الخطباء بل وكثير من الناس.
أ ـــ همّ الخطبة وقلق الخطيب:
لا شك أن الخطبة همّ عند من يتحسبون إفادة الناس، وتوجيههم للخير، وتحذيرهم من الشرور والفتن، وهو بهذا الاعتبار همّ محمود، ولا شك أن عددًا من الخطباء يحل بساحتهم نوع من القلق في نهاية الأسبوع بواعثه.
أ- الرغبة في اختيار الموضوع للخطبة من جانب.
ب- تحديد وانتفاء عناصر الموضوع المختار من جانب آخر.
ج- واستكمال ذلك بالرجوع لعدد من المصادر المهمة، أو المراجع ذات العلاقة بالموضوع.
د- ثم همّ الصياغة واختيار العبارات المناسبة.
هـ- وأخيرًا هم الإلقاء بطريقة تؤثر في جمهور المستمعين للخطبة.
فتلك هموم خمسة يعيشها كثير من الخطباء، ولكن ثمة أمور خمسة تخفف منها، وتحيلها راحة وطمأنينة ومثوبة للخطيب، وهي:
أ- الإخلاص في قصد الخطيب، والرغبة في الإفادة دون طلب الثناء أو التطلع للشهرة.
ب- المثوبة العاجلة التي يراها الخطيب في استجابة الناس للخير الذي دعاهم له والبعد أو الإقلاع عن الشر الذي حذرهم منه.
ج- وما ينتظر المثوبة الآجلة أعظم وأكبر حين تتطاير الصحف وكل نفس بما كسبت رهينة، ويُجازى معلمو الناس الخير على القطمير والنقير وخير الناس أنفعهم للناس.
د- التفكير المسبق بالخطبة يريح الخطيب، ويعين على إخراج الخطبة إخراجًا جيدًا، وتأخير ذلك إلى نهاية الأسبوع، فوق ما فيه من همّ وقلق فهو عرضة للانشغال والارتباط المفاجئ وكل ذلك يؤثر سلبيا على الخطبة (موضوعًا، وعناصرًا، وإخراجًا).
هـ- اختيار عدة عناوين وموضوعات للخطيب- سلفًا- وتحديد مظان عناصرها، ومواردها يسهم في إخراج خطب جيدة يستفاد منها مستقبلًا، ويوفر للخطيب احتياطا مهما
عند الحاجة، ويساعد على تنوع موضوعات الخطبة.
ب ـــ عوامل تأثير الخطبة في السامعين:
لا شك أن توفيق الخطيب وبخاصة في خطبته فضل من الله يؤتيه من يشاء وهو أعلم وأحكم ، ولكن يمكن تلمس ذلك في الأسباب الآتية:
- الصدق في القول والإخلاص في العمل.
- اختيار الموضوع المناسب زمانًا ومكانًا، وتوافقه مع حاجة المخاطبين.
- شمولية العرض له واستيفاء عناصره المهمة دون إطالة مملة.
- أسلوب الإلقاء واختيار العبارات المؤثرة، وأساليب شد الانتباه.
- مراعاة أحوال المستمعين في خطابه، وتغليب جانب الاختصار مع التوضيح لإصابة السنة.
- الدعاء بأن يرزق الله الإخلاص وحسن الأداء والعمل.
- سعة ثقافة الخطيب وإطلاعه المستمر على كل جديد من أهم عوامل صناعة الخطبة.
- تنوع موضوعات الخطبة (في العقائد، والأخلاق، والآداب، والسير، والأحكام، والفرائض، والسنن، وأحوال المسلمين، وواقع الأمم).
- استثمار النصوص والخطابة بلغة العصر، واستشعار واقع الناس ومخاطبتهم بما يعرفون.
- الاستفادة من عرض النماذج العالية والقصص الصحيحة أحيانًا فهي مواد للتشويق والإثارة.
- عدم تيئيس الناس وتقنيطهم، ومعالجة الأخطاء برفق وحكمة، وفتح المجال للتوبة والإنابة للمسرفين، ومن هدي النبوة: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا.
- تفاعل الخطيب مع مادة الخطبة، ورفع صوته أحيانًا وخفضه أحيانًا أخرى، كل ذلك يشد انتباه الحاضرين للخطبة، ويدعو لتفاعلهم مع الخطيب، وقد قيل «لا يؤثر إلا المتأثر».
ج ـــ أحكام ومسائل متفرقة متعلقة بالخطبة:
أ- المسألة الأولى: حكم خطبة الجمعية.
المسألة فيها خلاف والجمهور على أن خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة، فلا بد أن تتقدمها.
فإذا لم تتقدم الصلاة خطبتان أو تأخرت بعد الصلاة فلا تصح.
والدليل على اشتراط الخطبتين ما يلي:
- قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: 9].
وجه الاستدلال: أنه أمر بالسعي إلى ذكر الله من حيث النداء، وبالتواتر القطعي أن النبي ﷺ كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خطب، إذن السعي إلى الخطبة واجب، وما كان السعي إليه واجبًا فهو واجب، لأن السعي وسيلة إلى إدراكه وتحصيله، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية. - أن النبي ﷺ «حرم الكلام والإمام يخطب» وهذا يدل على وجوب الاستماع إليهما، ووجوب الاستماع إليها يدل على وجوبها.
- مواظبة النبي ﷺ عليهما مواظبة غير منقطعة، وهذا الدوام يدل على وجوبها.
ب- المسألة الثانية: حكم الانصات للخطبة:
حكم الإنصات واجب لحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت.
وجه الاستدلال: يأخذ من دلالة الموافقة «لأنه إذا جعل قول (أنصت) مع كونه أمرًا بمعروف لغوا فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغوًا».
والتحريم إنما هو في حال الخطبة فعلى هذا يجوز الكلام قبل الخطبة وبعد الخطبة وذلك لأن النبي ﷺ قيد الحكم بما إذا كان الإمام يخطب والمقيد ينتفي الحكم عنه بانتفاء القيد.
قال الحافظ في الفتح: الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة، كتحذير الضرير من البئر وأيضًا يستثنى من التحريم إذا خاطب المأموم الإمام فإنه يجوز لحديث أنس رضي اللَّهُ عَنْهُ : «أن رجلًا دخل المسجد والنبي ﷺ يخطب الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال…».
هـ- المسألة الثالثة : شروط الخطبة:
- الشرط الأول: حمد الله ، بأن يحمد الله، بأي صيغة، سواء كانت الصيغة اسمية أم فعلية، أي سواء، قال: الحمد لله، أو قال :أحمد الله أو قال: نحمد الله، وسواء كان الحمد في أول الخطبة، أم في آخرها، والأفضل أن يكون في الأول.
- الشرط الثاني: الصلاة على رسوله محمد ﷺ .
- الشرط الثالث: قراءة آية. فإذا لم يقرأ آية لم تصح الخطبة. ويشترط في الآية التي يقرؤها أن تستقل بمعنى فإن لم تستقل بمعنى فلم يجزئ.
- الشرط الرابع: الوصية بتقوى الله ﷻ .
فلابد أن يوصي بتقوى الله، لأن هذا هو لب الخطبة، فإن أتى بمعنى التقوى دون لفظها بأن قال: يا أيها الناس افعلوا أوامر الله واتركوا نواهي الله فيصح، أو قال: يا أيها الناس أطيعوا الله وأقيموا أوامره، واتركوا نواهيه فيجزئ. - الشرط الخامس: أن يحضر الخطبتين العدد المشروط على اختلاف مذاهب أهل العلم في ذلك وعند الحنابلة يشترط أن يكون العدد أربعين، وقال بعض أهل العلم أنه يكفي اثنا عشر فقط لقصة نزول آية: ﴿﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾
فقد جاء أنه لم يبق معه عندما جاءت العير إلا اثنا عشر رجلًا .
فلا بد أن يحضر أربعون على المذهب من أهل وجوبها، فإن حضر الخطبة عشرون ثم لما أقيمت الصلاة قبل أن يشرع في الصلاة تموا أربعين، فإنه لا يجزئ.
ولو حضر أربعون نصف الخطبة لم يجزئ.
هذه الشروط ذكرها بعض أهل العلم لصحة الخطبة، ولكن قال بعضهم: إن الشرط الأساسي في الخطبة: أن تشتمل على الموعظة المرققة للقلوب، المفيدة للحاضرين، وأن البداءة بالحمد والصلاة على النبي ﷺ وقراءة آية ، أو ما أشبه ذلك كل من كمال الخطبة والأولى اشتمالها على ما ذكر خروجًا من الخلاف.
ح- المسألة الرابعة: ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة:
جرت عادة بعض أهل السنة من قديم الزمان على ذكر الخلفاء الأربعة الراشدين وغيرهم – كالعشرة المبشرين بالجنة- في خطبهم وذلك بالدعاء لهم والثناء عليهم حتى لقد عدَّ بعض أهل العلم ذلك من شعار أهل السنة.
ولعل أول من سنَّ ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة هو عمر بن عبد العزيز لما كان بعض بني أمية يسبون عليًّا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا من الأمور المبتدعة.
ويجاب عنه:
- أن ذكر الخلفاء على المنبر كان على عصر عمر بن عبد العزيز ، بل قد روي أنه كان على عهد عمر بن الخطاب رضي اللَّهُ عَنْهُ ، وحديث ضبة بن محصن رضي اللَّهُ عَنْهُ من أشهر الأحاديث في قصة أبي موسى الأشعري الذي كان يدعو في خطبته لعمر بن الخطاب رضي اللَّهُ عَنْهُ .
- أنه قد قيل: إن عمر بن عبد العزيز ذكر الخلفاء الأربعة لما كان بعض بني أمية يسبون عليًا، فعوَّض عن ذلك بذكر الخلفاء والترضي عنهم ليمحوا تلك السنة الفاسدة – كما سبق- .
- أن أهل السنة لا يقولون إن ذكر الخلفاء في الخطبة فرض، بل يقولون إن الاقتصار على عليّ وحده أو الأئمة الاثني عشر هو البدعة المنكرة التي لم يفعلها أحد، لا من الصحابة، ولا من التابعين، ولا من بني أمية، ولا من بني العباس، وإن كان ذكر علي لكونه أمير المؤمنين مستحبًا، فذكر الأربعة الذين هم الخلفاء الراشدون أولى بالاستحباب.
- أن ذكر الخلفاء الراشدين على المنبر يوم الجمعة إنما هو تعويض عن سبِّ من يسبهم ويقدح فيهم، ليكون ذلك حفظا للإسلام بإظهار موالاتهم والثناء عليهم، ومنعهم ممن يريد عوراتهم والطعن عليهم، ولو ترك الخطيب ذكر الأربعة جميعا لم ينكر عليه وإنما المنكر الاقتصار على واحد دون الثلاثة السابقين، كما أنكر على أبي موسى ذكره لعمر دون أبي بكر، مع أن عمر كان هو الحي خليفة.
وحاصل كلام شيخ الإسلام في هذا هو أن ذكر الخلفاء الراشدين لا يجب في كل زمان ومكان إلا إذا قدر أن الواجبات الشرعية لا تقوم إلا بإظهار ذكر الخلفاء فإنه يكون مأمورًا به في هذه الحال بحيث إذا ترك ظهر شعار أهل البدع والضلال كالاثني عشرية والتومرتية.
قال الشيخ محمد رشيد رضا: «الترضي عن الخلفاء الراشدين وسائر العشرة من الصحابة المبشرين بالجنة وقد شرع الله لنا أن ندعوا لأنفسنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهؤلاء العشرة خيارهم».
هـ- المسألة الخامسة : تحكم الدعاء في خطبة الجمعة:
يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى : ويستحب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه والحاضرين. .
قال المرداوي: بلا نزاع. وأشار بعض أهل العلم أنه باتفاق الأربعة لأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيها أولى.
وقد ذهب ابن حزم إلى مشروعية دعاء الخطيب في الخطبة.
وقد يستدل لأصحاب هذا القول بدليلين:
- حينما استسقى النبي ﷺ وهو على المنبر يوم الجمعة كما في الصحيحين.
- ما رواه أحمد عن حصين بن عبد الرحمن السلمي عن عمارة بن رويبة «أنه رأى بشر بن مروان رافعًا يديه يشير بأصبعه يدعو، فقال: لعن الله هاتين اليدين، رأيت رسول الله ﷺ على المنبر يدعو وهو يشير بأصبع». وفي رواية لأحمد «بأصبعه السبابة».
وقد ذهب الشوكاني إلى مشروعية الدعاء في الخطبة عملًا بهذا الحديث.
قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: «ينبغي أيضًا في الخطبة أن يدعو للمسلمين الرعية والرعاة».
ثم قال: «لكن قد يقول قائل: كون هذه الساعة مما ترجى فيها الإجابة، وكون الدعاء للمسلمين فيه مصلحة عظيمة موجودة في عهد النبي ﷺ ولم يفعله، فتركه هو السنة، إذ لو كان شرعًا لفعله النبي ﷺ ، فلا بد من دليل خاص يدل على أن النبي ﷺ كان يدعو للمسلمين، فإن لم يوجد دليل خاص فإننا لا نأخذ به، ولا نقول إنه من سنن الخطبة وغاية ما نقول: إنه من الجائز لكن قد روي أن النبي ﷺ «كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة» فإن صح هذا الحديث فهو أهل في الموضوع، وحينئذ لنا أن نقول: إن الدعاء سنة، أما إذا لم يصح فنقول: إن الدعاء جائز وحينئذ لا يتخذ سنة راتبة يواظب عليه، لأنه إذا اتخذ سنة راتبة يواظب عليه فهم الناس أنه سنة. وكل شيء يوجب أن يفهم الناس منه خلاف حقيقة الواقع فإنه ينبغي نتجنبه.
و- المسألة السادسة: الدعاء للسلطان في الخطبة:
الدعاء للسلطان أو ولاة الأمور مسألة لا تخلو من حيث القسمة من حالين:
الحالة الأولى: أن يدعى له مطلقا دون تقييد بخطبة أو نحوها.
الحالة الثانية: فهي أن يدعى له حال الخطبة.
فأما الحالة الأولى: فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة: طاعة ولاة الأمر بالمعروف، وأن ذلك فريضة ما لم يأمروا بمعصية، والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق للخير والسداد.
يقول الطحاوي : «وترى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة».
قال بعض أهل العلم: وأما الدعاء مطلقًا لولي أمر المسلمين منهم فهو مستحب، ومن ذلك ما ثبت عن الفضيل بن عياض : أنه قال: «لو أن لنا دعوة مستجابة، ما صيرناها إلا للإمام».
وفي كتاب «السنة» للخلال بسنده عن الإمام أحمد: «وإني لأدعو له- الإمام- بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار، والتأييد، ورأى ذلك واجبًا عليّ).
فمن تتبع كلام أهل السنة والجماعة علم أن الدعاء مطلقًا لولاة الأمور بالصلاح والهداية أمر مبذول ومطروق لأن الدعوة للسلطان متعدية المصلحة بحيث إنه إذا صلح صلح بصلاحه العباد والبلاد، ومما يستأنس به فيما يتعلق بالدعاء لمولاة الأمر ما جاء عن النبي ﷺ أنه قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتعلنونهم ويلعنونكم».
المقصود بالصلاة هنا: «الدعاء» على أحد التفاسير.
هذا حاصل ما يخص الدعاء للسلطان مطلقًا دون تقييد.
أما الحالة الثانية: وهي التي تعنينا هنا، حيث تخص الدعاء للسلطان أثناء الخطبة.
قال ابن قدامه: «وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن. واستدل بدعاء أبي موسى الأشعري لأبي بكر وعمر أثناء الخطبة».
وقال أيضًا : «ولأن سلطان المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم ففي الدعاء له دعاء لهم، وذلك مستحب غير مكروه».
قال الشيخ عبدالله أبو بطين رحمه الله «الدعاء حسن، يُدعى بأن الله يصلحه ويسدده ويصلح به، وينصره على الكفار وأهل الفساد، بخلاف ما في بعض الخطب من الثناء والمدح بالكذب، وولي الأمر إنما يُدعى له لا يمدح لا سيما بما ليس فيه… الخ».
وفي فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصه «الأفضل إذا دعا الخطيب أن يعم بدعوته حكام المسلمين ورعيتهم، وإذا خص إمام بلاده بالدعاء بالهداية والتوفيق فذلك حسن، لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين إذا أجاب الله الدعاء.
ز- المسألة السابعة: رفع اليدين للدعاء في الخطبة:
الصواب في هذا أن اليدين لا ترفع للدعاء في الخطبة لحديث عمارة بن رويبة عند مسلم أنه رأى بشر بن مروان على المنبر فكايده فقال: قبّح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله ﷺ ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال: «ارفع الأيدي يوم الجمعة محدث».
قال البيهقي: «من السنة ألا يرفع يديه في حال الدعاء في الخطبة ويقتصر أن يشير بأصبعه»
إلا أنه إذا استسقى الإمام في خطبته فإنه يرفع كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ في صحيح البخاري.
ح- المسألة الثامنة: الخطبة بغير العربية أو ترجمتها لغير العربية:
لم يثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أنه يشترط في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية، كما أنه لم يأت ما يدل على أن النبي ﷺ أو أحد من الصحابة أو القرون المفضلة قد خطب الجمعة بغير العربية مع وجود الأعاجم وانتشارهم في بلاد المسلمين بعد الفتوحات الإسلامية، وإنما كان ﷺ هو وأصحابه ومن بعدهم يخطبون باللغة العربية.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : «ولعل الأظهر والأقرب- والعلم عند الله تعالى- أن يفصل في المسألة فيقال: إن كان معظم من في المسجد من الأعاجم الذين لا يفهمون اللغة العربية فلا بأس من إلقائها بغير العربية أو إلقائها بالعربية ومن ثم ترجمتها وأما إذا كان الغالب على الحضور هم ممن يفهمون اللغة العربية ويدركون معانيها في الجملة، فالأولى والأظهر الإبقاء على اللغة العربية وعدم مخالفة هدي النبي ﷺ ، لا سيما وقد كان السلف يخطبون في مساجد يوجد فيها أعاجم، ولم ينقل أنهم كانوا يترجمون ذلك.
وأما ما يدل على الجواز عند الحاجة فإن لذلك أصلًا في الشريعة وهو قوله ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم﴾ [إبراهيم: 4] ومن ذلك أن الصحابة رضي اللهُ عَنْهُمْ، لما غزوا بلاد العجم من فارس والروم لم يقاتلوهم حتى دعوهم إلى الإسلام بوساطة المترجمين.
ووافق سماحة الشيخ على هذه المسألة اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة واختاره الشيخ محمد العثيمين كما في شرحه على الزاد.
سؤال: متى تكون الترجمة إذا احتيج إليها؟
الجواب: المسألة فيها خلاف والذي يظهر- والله أعلم- أن الترجمة قبل الخطبة مطلقًا أو بعدها مطلقا لأن المقصود الإفهام، ولا بد أن في الترجمة أثناء الخطبة أو بين الخطبتين أو بعدها وقبل الصلاة إطالة وتشويشًا ونقصًا في الموالاة.
قال ابن قدامة: «والموالاة شرط في صحة الخطبة….الخ».

وصايا لقمان الحكيم
الخطبة الأولى إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستهديه، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا...

الصراع بين الحق والباطل
الخطبة الأولى الحمد لله الذي جعل الحق ناصعًا أبلجًا، وجعل الباطل مظلمًا لجلجًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده...

التحذير من الربا
الخطبة الأولى الحمد لله ذي الجلال والإكرام، والطول والإنعام، أحل لعباده الطيبات، ومحق بركة الحرام، فله الحمد على لطفه وإحسانه...

التقوى
الخطبة الأولى الحمد لله رب العالمين، أمر بتقواه، ووعد المتقين خيرًا كثيرًا، أحمده سبحانه ولي المتقين، وأشهد أن لا إله...

فضائل الجمعة وخصائصها
للجمعة فضل عظيم ولها خصائص تتميز بها نعرض لها في مبحثين: المبحث الأول: الأدلة الدالة على فضل الجمعة ثبت في...