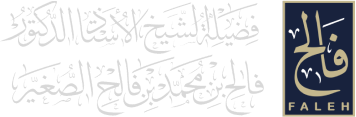
الربيع العربي ومصدرية التلقي

لا تجلس مجلسًا من المجالس الفكرية -وبخاصة عندما يكون الحديث عن حوادث كبرى- إلا وتجد التسابق إلى المشاركة في الكلام، كل سيدلي بدلوه، وسيبدى رأيه بكل حماسة ومحاولة وإقناع، وقد ينتقل هذا الطرح إلى منتدًى في النت، أو مقال في الصحافة الورقية، أو الإلكترونية إن لم يتجاوز أكثر من ذلك. ويشتد هذا الأمر عندما تكون الأحداث ساخنة كأحداث «الربيع العربي».
وهذا الحديث بحدِّ ذاته ليس موضوع مدح أو قدح، بقدر ما يكون ظاهرة من الظواهر تستحق التأمل والنظر.
هذه الوضعية تُحدث تساؤلًا عميقًا يحتاج إلى عمق في الإجابة لا من منظور شخصي أو رؤية ذاتية فحسب.
هذا التساؤل يقول: في كل هذه الأحداث الذي يبني عليها كثيرون آراءهم ومواقفهم: ما مصدريتهم في التلقي للمعلومة، أو للحيثيات الممهدة للرأي، أو مصادر جمع القرائن والأدلة؟! ومن ثَمّ تكوين موقف يحسب عليهم ويحسبون عليه.
أحسب أن الإجابة عن هذا التساؤل عن معرفة المصدرية للتلقي هي بداية الاتجاه السليم، وهي المحددة للمسار الموصل للنتيجة المتوخاة، كما أن الإجابة ستختصر كثيرًا من الجهود، والأوقات، والتفكير، وتُخلص من التبعية المطلقة للغير، ومن هنا تكتسب معرفة المصدرية تلك الأهمية الكبرى وبخاصة من روَّاد المعرفة وأهل الفكر والثقافة، والرأي، والمتعاملين مع الكلمة وفعاليتها.
خذ مثلًا -من التاريخ العباسي- ما الذي جعل بعض خلفاء بني العباس يتأثرون في مسائل تخالف أحيانًا صريح القرآن الكريم مع قربهم من العهد النبوي الذي لم يمض عليه أكثر من قرن وفي وقت يشتغل علماؤه في تأسيس العلوم الشرعية مع كثرة العلماء وفي بغداد خاصة؟
إنَّ مصدر التلقي الوافد من الفكر الفلسفي اليوناني وغيره، وتلقي غثه وسمينه، وتفعيله جميعه هو المؤثر في شيوع الفكر المخالف.
ومثال من الواقع المعاصر: ما الذي جعل بعض أبنائنا يتأثرون بفكر العنف العملي، وفكر التكفير العقدي، فأثَّر في مسيرة حياتهم وضحَّوْا بعقولهم وقدراتهم وأجسامهم؟ لا شكَّ أنَّ الأساس هو مصدر التلقي الذي يصدِّر هذا الفكر بفهم سقيم، أو بعداوة متقصدة للإسلام وأهله.
ومثال آخر: تجد بين وقت وآخر ظاهرة سلوكية مخالفة لأعراف المجتمع وتقاليده، بل أحيانًا مخالفة لدينه ومعتقده وأخلاقه، كظاهرة التعامل مع السحرة وتعاطي السحر، وعندما تتأمل كيف نشأت هذه الظاهرة في مثل مجتمع يحاربها في أصلها، تفاجأ بأنَّ المتعاملين معها تلقوا الفكرة من مصدر دخيل؟ ومن هنا ألج إلى الموضوع الذي أبدي فيه هذه الوجهة لعلَّها تصب في وادي العطاء المتحرك ليحرك ساكنًا أحسب أن إيجابيَّتَه في حراكه.
هذا «الربيع العربي» -كما يُسمَّى- ما مصدرية الاسم؟ وهل له دلالة؟ وهل هو ربيع؟ مجرد تساؤل.
والأهم: في الحقائق، فكل المهتمين يتابعون أحداثه، لكن لا أظنُّ أنَّ أحدًا يخالف -كما ناقشت كثيرين- في أن مصدر التلقي الأساس للأحداث، وتوجيهها، وصياغتها وبناء الآراء والمواقف عليها، والتحكم فيما ينقل منها، هو: الإعلام بمختلف قنواته، وبالأخص القنوات الفضائية الإخبارية.
والإعلام -مصدر لا يجوز إنكاره- ولا يجوز الاستهانة به، ولا يجوز التقليل من تأثيره سلبًا وإيجابًا، ولا يجوز إغماض العينين عما يبثه، ولا صم الأذنين عما يلقيه، ولا يجوز استغفال المتعاملين معه، تلك حقيقة لا تُنكر، ومن ينكر ذلك ينكر واقعه.
ومن الإعلام: الجوَّال الشخصي لتمتعه بخاصية من خصائص الإعلام المرئي، لكن: هل يجوز أن يكون الإعلام كل شيء في مصدرية المعلومة، وفي التحليل لها، وفي صياغة الكلمة، وتوجيهها وتحديد المواقف والحماسة لها؟ وإذا كان هذا واقعًا فالسؤال: مَن الذي يصوغ المادة الإعلامية، ويسيِّر سياسة هذا الجهاز الإعلامي؟ وبمعنى آخر أكثر مباشرة: ألا يصبح مسيِّر القناة الإعلامية هو محدد التوجه، ومصوِّر المعلومة ومصدِّرها؟!
وبناء على هذا: ألا يمكن لأهل الرأي والفكر أن يبحثوا عن مصادر أخرى للتلقي؟ وهل في ثقافتنا ما يهدي إلى إمكانية تقويم ما يطرح وما يشاهد؟ هذه مجرد تساؤلات، أخلص إلى أنه يمكن بالتفكير أن يذكر ما يفيد في هذا الباب، مع الإيمان بما ذكر من فرضية الإعلام نفسه مصدرًا أساسيًّا لتلقي الأحداث المعاصرة من خلال ما يتمتع به.
ومن ذلك:
- دراسة التاريخ بأحداثه، وأحواله، وتغيراته. نعم، للتاريخ تأثير في الحاضر، فالحاضر امتداد له وتأثير على المستقبل باستشرافه، وهذا يوجب مسؤولية كبيرة على المختصين في التاريخ ليبرزوا ما يفيد في هذا الباب، ومثال ذلك: ما حدث في التاريخ القريب من الاستعمار لبعض البلدان العربية في أوائل القرن الماضي، والمتغيرات التي صحبته، كيف نفيد منها ونحن نعايش ما يسمى «الربيع العربي» جدير بأهل الفكر والتاريخ أن يربطوا الأحداث ليستخرجوا ما يفيد.
- السنن الإلهية في الكون، فالسنن لا تتغير على مدى الزمان، وفي أي مكان، سواء كانت سُننًا شرعية، كسُنة الظلم وعواقبه والطغيان، أو كونية قدرية مثل ما يتعلق بالرياح، والأمطار، وغيرها فهل يمكن استحضارها من القرآن الكريم والسُّنة النبوية وتنزيلها على شيء من الواقع؟ وهذا يتم بالمدارسة والمحاورة، وأذكر من هذه السُّنن سُنة التدافع بين القُوَى، قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ [البقرة: 251] وسنة عاقبة الظلم: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ [إبراهيم: 42] وسنة التغيير ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [الرعد: 11]. وغيرها كثير، وتلك مجرد أمثلة لتنزيلها على الواقع الذي يجب أن يزيح عنها أهل العلم والرأي والتخصص الستار بدون مجاملة أو تواري.
- ومن المصدرية التثبت من المعلومة، كما هو مبدأ من مبادئ ديننا الذي نعتزُّ به، قال الله سبحانه وتعالى مرشدًا إيانا: ﴿ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6]، وواقع الحال أنَّ مصدر المعلومة للوقائع الإعلام، والمناقشة لما جاء فيه، وإن سكت الإعلام سكت المتلقي، وإن غير مجرى الحديث كذلك، ولسان الحال: فأينما ولَّى وجهه ولَّى الناس وجوههم، ألا يمكن تفعيل التثبت من المعلومة، وبخاصة المعلومات المرتبطة بواقع دقيق؟ ومثال ذلك: علماء البلد الذي تقع فيه الحوادث ما رؤيتهم لواقعهم؟ وما تقويمهم لما يقع؟ وكذا مفكروه، ومثقفوه، وأهل الرأي فيه، وإذا كان يقال عن هذا العصر: عصر التقنية والسرعة ألا تفعَّل هذه التقنية في تلقي ما لدى أولئك المفكرين والعلماء. وآية ذلك: أننا نسمع عنَّا من الآخرين في خارج بلادنا ما لا نرتضيه، وما لا يصحح واقعًا، ولا نتيجة. فالإعلام سلاح ذو حدَّين، وقد يغلِّب وجهة على أخرى، فتهميش أهل الفكر والعلم من مصدرية التلقي يحدث فراغًا هائلًا في صحة المواقف والنتائج، وفي إيجاد التشويه بعمد أو بغير عمد.
- ومن تكامل المصدرية الاطلاع على ما يكتب في مراكز الدراسات الفكرية، والاستشرافية، والسياسية في الغرب والشرق ففيها كثير من المعلومات، والحقائق، والنظريات، والرؤى، والتحليلات، التي لا يظهرها لنا الإعلام المرئي، ولا شكَّ أنَّ كثيرًا منه مثل غيره يحتاج إلى تثبت، أو هو رؤية خاصة، أو استشراف ظني، لكن بلا شك يكون إضافة تفيد في النظرة إلى الأحداث القائمة أو المتوقعة، كما تعين على تجديد المواقف، وتصوِّب بعض الرؤى. أظنُّ من الخير عدم إغفالها لمهتم بهذه الشؤون ليكمل رؤيته التي يريد أن يبني عليها برامج عمل.
- ومما يذكر هنا في المصدرية: الاستعداد النفسي لسماع الوجهة المخالفة، ولذلك يطغى على بعض المجالس والمنتديات الحكم القاطع السريع على المخالف للوجهة العارمة، فيقال مثلًا: ما دور أعداء الأمة ومواليهم في صناعة الحدث، أو استثماره؟ وكيف يتم التعامل معه؟ ونحو ذلك يأتيك الجواب العارم الجاهز بأن هذا القول يتسق مع نظرية المؤامرة، ومعنى ذلك أنَّ الرؤية المخالفة خطأ مئة في المئة، ولا يجوز سماعها مئة في المئة لأنها تكريس لمبدأ المؤامرة، ويخالف هوى النفوس مع ما يحدث، هذا مثال لا يعني طرحه أنني أوافقه أو أخالفه، لكنها دعوة لتحكيم النظر العقلي، والتأمل في الواقع، وسعة النظرة، وفتح الآفاق للتعامل مع مختلف التوقعات في الموضوع.
- وأخيرًا: وهو أهمها بالنسبة لنا نحن المسلمين، لدينا مصادر للتشريع وللقياس والتقويم لا خلاف عليها، وهي تكون أصولًا في النظر للمواقف كما هي أصول للنظر في الأحكام والتشريعات، ومثال ذلك مما يخص هذه الأسطر: قضية: من العدو؟ ومتى ينبغي التغيير؟ وما موازينه؟ وما أهدافه وغاياته؟ ولتطبيق ذلك: تسمع كثيرًا: المهم يتغير الطاغية؟ والسؤال ما الهدف؟ والجواب، لا جواب، المهم يتغير. أما في القرآن: فالتغيير للإصلاح بمعنى التغيير الإيجابي، والإصلاح والتغيير يخضع لموازين المصالح والمفاسد الكبرى، ومَنْ يقدر ذلك؟ هم أهل العلم والرأي والتخصص والفكر والمشورة والخبرة والحكمة، لا أنه يكون الموجه حماسة شبابية أو عاطفة مسيرة، أما الواقع: الشباب يريد كذا، ولكن من هؤلاء الشباب؟ وكيف تكوَّنوا؟ ومن صدَّرهم؟ وكيف تنضج آراؤهم؟ فالمسألة إذًا تحتاج إلى عمق النظر في موازين الشريعة لتحدد لنا مصدر التعامل مع الحدث أو الأحداث، وتحدد المواقع، وإن خالفت طموحات النفوس ورغباتها، ومرة أخرى تأكيدية: المراد هنا إبراز ما يتعلق بمصدرية التلقي، وليس موافقة لطرح أو مخالفة له.
وبعد: فتلك سطور من مجموع التعامل مما يقع من أحداث من هنا وهناك، ولعلَّ ما مضى من الأشهر الماضية كفيل بأن يكون هناك شيء من الهدوء الذي يعطى آمالًا وتفاؤلًا في المستقبل، تقوم معطياته الحاضرة على قواعد سليمة، وأسس راسخة، في برامج فاعلة للإصلاح الحقيقي للأفراد والمجتمع والأوضاع.
أقول هذا للمؤسسات الفاعلة، ومراكز الأبحاث وما شابهها ممن حمل على عاتقه التوجيه وتحمس لذلك، كما هي دعوة لكل متابع ومهتمٍّ وللشباب خاصةً أن يُعمل فكره على أُسس علميَّة، لا أن يكون مجرد تابع للإعلام، وبالأخص الفضائيات، بما لها وما عليها، ولكن ليكن هذا الإعلام عاملًا من العوامل، قابلًا للتقويم والنظر وفق الموازين السليمة على منهج قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ [سبأ: 46].
سدد الله الخطى.